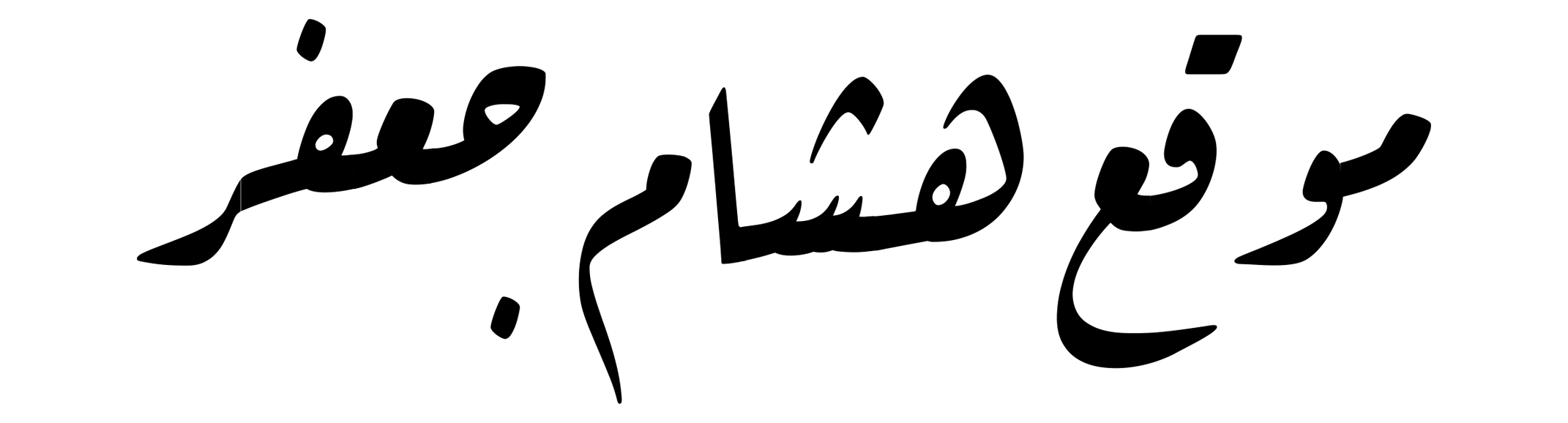كنت استعد أن أكتب مقالي الشهري لـ «مدى مصر» مشتبكًا فيه مع مقال الزميل العزيز محمد سعد عبد الحفيظ الذي نشره في نفس الموقع تعليقًا على أزمة تونس، ثم داهمتنا أحداث الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ودخول طالبان إلى العاصمة كابول. وما بين الحدثين كان احتفالنا نحن المصريين بفوز ثلاث فتيات «محجبات» بالميداليات الأولمبية. توقفت متأملًا لعل أطروحتي حول «فائض الإسلاموية» التي أردت أن أتناول بها مقال صديقنا عبد الحفيظ، وقد تصادف أن نشر بجوارها مقال آخر للكاتب التونسي منير السعيداني، أعتبره من أهم ما قرأت عن أزمة تونس، تصلح نموذجًا تفسيريًا لجدلنا العام حول الأحداث الثلاثة.
الهوس الغربي بالإسلام
هناك هوس غربي متصاعد بالإسلام يخلق نقطة عمياء في تحليل بعض أهم التطورات الحالية في الشرق الأوسط الكبير (بتعبيرهم والذي يمتد حتى أفغانستان ويشمل منطقتنا أيضًا). خاصة أن هذه المبالغة قد اكتسبت الآن بُعدًا إضافيًا يتعلق بتهديد للديمقراطية الغربية والنظام الدولي الليبرالي وحقوق ومكتسبات المرأة والوجود المادي للتطرف العنيف.
هناك ميلًا إلى المبالغة في تقدير دور الإسلام كمحرك مركزي لجميع المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في الشرق. ففي زمن الترامبية في أمريكا والشعبوية الوطنية في جميع أنحاء أوروبا، ترى أغلبية كبيرة أن الإسلام مصدر لانعدام الأمن والعلامة الأساسية للهوية والصراع في الشرق الأوسط، وفي جميع القضايا الإقليمية تقريبًا، بدءًا من التحول السياسي في تركيا في عهد أردوغان، إلى الانقلاب في مصر الذي أطاح بجماعة الإخوان المسلمين. أو من صعود تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش) إلى الصراع الطائفي السني الشيعي. غالبية الغربيين ينظرون إلى المنطقة من منظور الإسلام، وحكمهم كئيب للغاية، فهو لا يتوافق مع الديمقراطية والعلمانية والحداثة والمساواة بين الجنسين والعديد من القيم التقدمية الأخرى التي يتبناها الغرب. ويُنظر إليه أيضًا على أنه دين استبدادي وغير متسامح وعنيف ومقاتل، ونادرًا ما يُنظر إلى مثل هذه التعميمات الكاسحة على أنها تأكيدات سطحية تستند إلى الحتمية الدينية والثقافية. ويلاحظ أنه تم استبدال الكليشيهات الاستشراقية التي تصور الإسلام، ليس فقط على أنه دين، و«طريقة حياة» بالرأي القائل بأن الإسلام هو المشكلة. هذه الرؤية تحمّل الدين والعنف الديني المسؤولية عن معظم المشاكل الأمنية وتقريبًا جميع التحديات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في البلدان الإسلامية.
المشكلة مع هذه التصورات أنها تستند إلى الحتمية الثقافية والدينية، وترى مستقبل المسلمين هو الماضي الغربي الذي يجب أن يسلكوه كما سلكه الأولون الغربيون. وإذا كان الإسلام هو المشكلة الرئيسية، فلماذا لا يقدم أيضًا الحل الرئيسي؟ هذا النوع من الحتمية الإسلامية يتسم بالثبات رغم التغير الذي هو سمة العصر. ووفقًا لهذه الوصفة، لإنقاذ الإسلام من نفسه، فكل ما نحتاج إليه هو مارتن لوثر المسلم الذي سيقوم بإصلاح وتحديث وتعديل الإسلام على غرار الصدام الأوروبي في القرن السادس عشر بين البروتستانتية والكنيسة الكاثوليكية.
إن الافتراض بأن الإسلام هو المصدر الرئيسي للهوية السياسية، وبالتالي السبب الرئيسي لجميع المشاكل، في الشرق الأوسط، يحرك استراتيجيات مضللة في مجالات حساسة مثل مكافحة التطرف أو تعزيز الديمقراطية. صحيح أن العنف المتطرف والأنظمة الاستبدادية المختلة هي مشاكل حقيقية في العالم الإسلامي، لكن مثل هذه الحقائق السياسية تحتاج إلى تحليل موضوعي دون اللجوء باستمرار إلى الحتمية الثقافية والدينية الكسولة. فالهوس بالإسلام يخلق وهمًا بصريًا كبيرًا يشوه الحقائق على الأرض، الحقائق التي تتطلب تحليلًا سياقيًا تفصيليًا. كما أن سراب الإسلام هذا، في الوقت الحالي، يغذي التوتر والاستياء والاستقطاب المتزايد بين الغرب وعالم الإسلام، وإذا لم يتم التصدي له، فإنه سيؤدي إلى تفاقم الديناميكيات القوية بالفعل للإسلاموفوبيا. كما ينتج نبوءة أخرى مدمرة تحقق ذاتها: تطرف مجموعات كبيرة من الشباب المسلم في الشرق الأوسط وأوروبا. الهوس بالإسلام لن يجعل الصراع الحضاري أبديًا فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تفاقم استياء وإحباط ملايين المسلمين. إن الثقافة الفارغة، ذات الدلالات العنصرية التي تبالغ في تقدير الطبيعة الخطرة للإسلام، سوف تمهد الطريق لما يخشاه الغرب أكثر من غيره: التطرف الإيديولوجي والعنف المتطرف في العالم الإسلامي.
الهوس بالإسلامية
إذا كان الهوس الغربي بالإسلام يخلق نقطة عمياء في التحليل لا تسمح له بالبحث في سياقات الظواهر وتعمق من سياسات الهوية وصراعاتها، فإن الهوس بالإسلامية يؤدي إلى التغطية -بتعبير إدوارد سعيد في كتابه الهام تغطية الإسلام- على عديد من القضايا والموضوعات، ومعه نصبح بإزاء إخفاء وتغطية كاملة شاملة، ولكن على نحو مضلل لأنها تمنحنا شعورًا بالفهم دون أن تعلمنا بقدر كاف، ونصبح بين تغطية الظواهر والتغطية عليها.
الهوس بالإسلامية بمعنى اختزال الظواهر المركبة وتبسيطها في البحث عن مدى حضور الإسلامية فيها، وعلاقتها بالإسلاميين أو علاقة الإسلاميين بها يستند إلى أسس أربعة:
1- استثنائية الظاهرة الإسلامية. وهنا تكمن المفارقة حين يتواطأ الإسلاميون ومنتقدوهم على حد سواء على تقديمها باعتبارها استثناء -وإن اختلفت الدوافع بينهما. فالاتباع يريدون أن يضيفوا عليها نوعًا من القداسة، في خلط واضح بين النص المُنزل والتعبير عنه خطابًا وممارسة. أما المعارضون فقد أرادوا التشكيك في قدرة الإسلاميين على الاندماج في النظام السياسي سبيلًا لحرمانهم من الوجود.
ما يجب أن أشير إليه هو نهاية الاستثنائية الإسلامية هذه. فالانطباع الرئيسي الذي تخرج به بعد الإنتهاء من متابعة أداء الإسلاميين -وطالبان جزءً منهم- السياسي في الربيع العربي -خاصة في موجته الثانية 2019 وقد بات بعض أطرافهم في الحكم أو مساندين له، هو تطبيع هذه الحركات مع الواقع بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات سلبية وإيجابية، بما يمكن معه القول بانتهاء «الاستثنائية الإسلامية» التي حاول -كما قدمت- أن يصمها بها تابعيها ومعارضيها على حد سواء.
الإسلاميون في السلطة -كما في المعارضة- يتصرفون مثل الفواعل السياسية الأخرى حين تحركهم إدراكاتهم لمصالحهم الذاتية التي يبغون تحقيقها، ويبنون تحالفاتهم ليس وفق أسس أيديولوجية بل كان التنافس في ما بينهم أشد وطأة من تنافسهم مع غيرهم. والأهم أن الربيع العربي بموجتيه أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنهم لا يملكون مشروعًا فارقًا للسلطة بل يتصرفون كأي حاكم عربي: الانتهازية السياسية التي طبعت تجربة وممارسة كثير منهم في الحكم وخارجه، وتقلبات مواقفهم وتحالفاتهم، وتعدد انتقالاتهم من خندق إلى آخر، وتفشي مظاهر الفساد في بعض أوساطهم.. أسقط عنهم لباس «التقوى»، وأزاح من فوق رؤوس قادتها «هالة القداسة».
2- الحتمية الثقافية والاجتماعية. فالإسلاميون في كل مكان يتصرفون بنفس الطريقة أو علي حد تعبير الزميل عبد الحفيظ فإن «الطبع يغلب التطبع»، وهم كلًا واحدًا ليست هناك فروق بينهم ولا صراعات وتوترات داخلهم، ولا يجري ما يجري على غيرهم من تطورات وتغيرات وتحولات، وإن كانت فلا بحث عن السياقات والأسباب التي تدفع إلى ذلك وإنما هي -أي التغيرات- تقية أو انتهازية سياسية أو تغيير تكتيكي، ويعمق من ذلك غياب المقارنة بينهم وبين غيرهم من الفواعل السياسية والاجتماعية الأخرى والتي بها نكتشف أوجه التشابه والاختلاف فيما بينهم.
3- الاختزالية المفرطة ممتزجة بنبرات توكيدية. فالواقع المعقد يتم تبسيطه بما يناسب المزاج العام، ويجري تقديم حلول شاملة لمشاكل تفصيلية معقدة. وثمّة إجماع على استخدام كباش فداء تلقي عليهم تبعات ما لا يروقنا في الواقع. ومناقشة تتسم بالتعميم وفق منطق الصناديق المغلقة والتصنيفات الجاهزة والصور النمطية دون البحث في التفاصيل ورسم الخرائط. وغياب المعلومات المدققة، مع صياغة الأسئلة الخاطئة من قبيل: «هل عودة طالبان انتصار للإسلام والمسلمين» بدلًا من الحديث عن تداعياته الجيواستراتيجية وتأثيرات نموذجهم الإسلامي على الصراع مع حركات الإسلام السياسي الدائر في المنطقة. وأخيرًا بناء علاقات سببية بين ظواهر من طبائع مختلفة مثل الحجاب والأوليمبياد.
4- غياب أي خطاب للنقد الذاتي. فالكل يلقي بالتبعية على الآخر دون حديث عن مساهمته في ما آلت إليه الوقائع والأحداث. فالإخوان هم المسؤولون في مصر وتونس عن عودة الاستبداد، لو عدنا إلى ما جرى وتتبعنا مسار خطايا «النهضة» ومناوراتها في العشرية الأخيرة سنصل إلى أن «الانقلاب على المسار الدستوري والديمقراطي» صُنع بأيدي إخوانية. وأن تونس تجني ما زرعه إخوان تونس كما جنا المصريون ما زرعه إخوان مصر- على حد قول صديقنا عبد الحفيظ. وفي المقابل فإن العلمانيين -هكذا كلًا واحدًا دون تمييز بينهم- هم المسؤولون عن استدعاء الجيوش وعودة الدولة العميقة لتحكم وتتحكم ولتنقلب على المسار الديمقراطي.
للمفارقة، نجد خطابًا أمريكيًا في الزمن الأفغاني يركز على الدروس المستفادة واعتراف بالأخطاء وتطلع للمستقبل حيث: «عقدان من الأخطاء وسوء التقدير والفشل الجماعي» بقلم سفير أمريكا السابق في أفغانستان ب.مايكل ماكينلي (2014-2016). وينشر كوردسمان في مركز التفكير الأول في واشنطن قبل أيام قليلة من دخول طالبان كابول: «التعلم من الحرب: من خسر أفغانستان؟ مقابل أن نتعلم لماذا خسرنا».
سياسة الكلمات
الهوس بالإسلامية تمخض عنه نمط جديد من العلاقات أطلق عليه توماس فرانك وإدوارد ويسباند اسم «سياسة الكلمات»، كما أوردها إدوارد سعيد في تحليله لتغطية الغرب للإسلام، فالمماحكة والأخذ والرد بين من يتبنى الإسلامية ومن يضادها، والتحدي والرد عليه، وفتح الباب أمام فضاءات خطابية معينة وإغلاقها أمام أخري، كل هذه الأمور تكوّن سياسة الكلمات التي يقوم كل طرف عبرها بابتداع ظروف وتبرير أفعال وإجراءات وإعاقة خيارات والضغط على الآخر كي يتبنى بدائل محددة. والأهم أنه يؤدي إلي إعادة إنتاج نفس الكلمات والقضايا برطانة جديدة صارت به اللغة فارغة لا تعبّر عن الأشياء كما هي، بل تجرّدها من واقعيتها وتحوّلها إلى سديم من المعاني الهائمة، برغم أن حاجة الناس باتت ملحة إلى لغة واضحة محددة وألفاظ دقيقة المعاني، حتى لا تتصادم المفاهيم ويتحول التعبير عن قضايا الناس وهمومهم إلى رطانة لا يعرفها إلاّ القليل أو لا يكاد يعرفها أحد. ولولا هذا الاستخدام الخاطئ والبعيد عن حقيقة الخطاب لما استشرت الخلافات حول القضايا المتفق عليها لدى الجميع. [تأمل كيف غاب صوت الفائزات بالأولمبياد وإدراكهن لذواتهن وموقع الحجاب من هذا الإدراك في مقابل تصاعد جدل الجميع حول الموضوع].
سياسة الكلمات تؤدي إلى عدد من الظواهر المتشابكة مع بعضها البعض أهمها: الاستقطاب على قضايا لا علاقة لها بأولويات الناس. وهنا أعود للمقال الذي نشره منير السعيداني أستاذ علم الاجتماع بتونس، متجاورًا لمقال الصديق عبد الحفيظ، حيث أعطي أبعادًا مركبة للأزمة التونسية لا يمكن لمن أراد أن يدلف إليها عبر بوابة الهوس بالإسلامية أن يدركها، ناهيك عن أن يتناولها أو يشير إليها. وهذا هو الانفصال الذي جرى في تونس على مدار العشرية الأخيرة بين الاحتجاج الاجتماعي المتصاعد، وبين التعبير السياسي الذي تجسده المؤسسات السياسية المختلفة من أحزاب وبرلمان وطبقة سياسية، ويرتبط بذلك قضية العلاقة بين المجتمع والدولة.
سياسة الكلمات المستندة إلى الهوس بالإسلامية تقوض الممارسة السياسية حين تجعل منها ذات طبيعة ثقافية تدور في أروقة النخب وبعيدة عن أية جذور اجتماعية، مما يسمح بالعصف بها في أية أزمة ومن قبل الأقوياء دائمًا، وتغطي على سؤال يجب أن يكون التركيز عليه: كيف يمكن للديناميكيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية أن تغير الميول الثقافية والأيديولوجية؟
عندما تتفوق الإسلامية على السياسة، يكون كل شيء مختلفًا: فلا حديث عن العقود الاجتماعية غير الاجتماعية التي تمارسها شبكات الامتياز بتحالفاتها الإقليمية والدولية. ولا تتم إعادة هندسة الاستقطاب على أسس ديمقراطية..إلخ. وبدلاً من ذلك، تهيمن الحروب الثقافية على السياسة، ويصبح الصدام بين القيم الإسلامية وغيرها من القيم الأخرى هو الموضوع المفضل للجميع برغم أن الاستناد إلى الدين في الواقع ينتج قيمًا متعددة وفي أحيان كثيرة متضادة برغم ديباجتها الدينية. والأخطر أنها تغذي سياسات الهوية التي تنشأ حين ينجذب كثير من الناس نحو مجموعات مألوفة ومتشابهة التفكير من أجل المجتمع والأمن، بما في ذلك الهويات العرقية والدينية والثقافية وكذلك التجمعات حول المصالح والأسباب، مما يخلق تنافرًا بين الرؤى والأهداف والمعتقدات المتنافسة. كما يتم إنشاء مزيج من الهويات العابرة للحدود، وانبعاث الولاءات الراسخة، وبيئة المعلومات المنعزلة، وتباين خطوط الصدع داخل الدول، وتقويض القومية المدنية، وزيادة التقلبات.
وهكذا تبدو السياسة اليوم تتمحور بشكل متزايد حول مسألة الهوية البدائية بدلاً من الإيديولوجية السياسية. ولكن عندما تخدش السطح، يصبح من الواضح أن بعض المشاكل الثقافية والهوية التي تستقطب السياسة لا تزال لها جذور اجتماعية واقتصادية أعمق تحركها وتغذيها. وبهذا المعنى يجب وضع سياسات الهوية في سياق اجتماعي واقتصادي مناسب، وسيكون من قبيل الخطأ الفادح أن نراها منفصلة تمامًا عن الحقائق المادية.
إن هوسنا بالإسلامية لن يجعل صراعاتنا أبدية ومستمرة فحسب، بل سيؤدي إلى مزيد من تسطيح الجدل العام وافتقاره إلى المقومات الأساسية من تعددية وتنوع بما تتضمنه من قدرة على التفاوض والمساومة والوصول إلى حلول وسط.