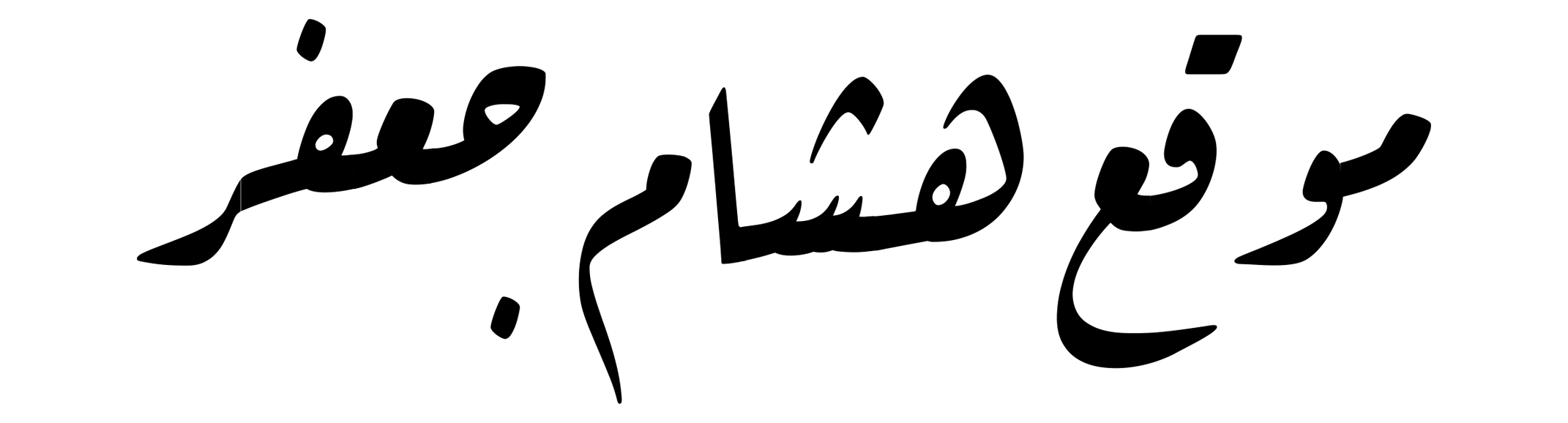يستكشف كتاب ديدييه فاسان “التنازل الأخلاقي: كيف فشل العالم في وقف تدمير غزة” مفهوم الموافقة متعدد الأوجه – السلبي والإيجابي – في سياق الإبادة في غزة، مجادلاً بأن الجهات الدولية الفاعلة قد تغاضت عن إبادة المنطقة أو دعمتها بنشاط. صدر الكتاب بالفرنسية أواخر العام الماضي، وتُرجم إلى الإنجليزية.
يناقش النص كيف أن تصنيف الأحداث، وخاصة هجوم 7 أكتوبر، يُشكّل الروايات، حيث يراه البعض عملاً معادياً للسامية، بينما يراه آخرون عملاً من أعمال المقاومة المتجذرة في القمع التاريخي. يدرس فاسان قمع المعارضة وإسكات الأصوات التي تنتقد السياسة الإسرائيلية، غالباً من خلال اتهامات بمعاداة السامية، وهو ما يرى أنه سوء تطبيق للمصطلح.
ديدييه فاسان هو عالم أنثروبولوجيا، وعالم اجتماع، وطبيب فرنسي بارز، وكان نائب مدير منظمة أطباء بلا حدود. يشغل حالياً منصب أستاذ جيمس د. وولفينسون في كلية العلوم الاجتماعية بمعهد الدراسات المتقدمة في برينستون، ومدير دراسات في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية بباريس، وأستاذ في كوليج دو فرانس (Collège de France)، حيث يشغل كرسي “القضايا الأخلاقية والمسائل السياسية في المجتمعات المعاصرة”.
ينتقد الكتاب عدم المساواة في القيمة التي توليها الحكومات ووسائل الإعلام الغربية لحياة الإسرائيليين والفلسطينيين، مسلّطاً الضوء على التفاوت في الحزن والاهتمام الإنساني. وفي نهاية المطاف، يرى الكتاب أن دعم الحكومات الغربية لإسرائيل ينبع من مزيج معقّد من الشعور بالذنب التاريخي، والمصالح الجيوسياسية، والروابط الاقتصادية مع صناعة الأسلحة، وكراهية الإسلام الكامنة.
طرق الموافقة
في سياق الصراع في غزة، تتجلّى “الموافقة على محو غزة” بطريقتين مختلفتين: بشكل سلبي ونشط.
تحدث الموافقة السلبية عندما يكون هناك فشل في معارضة مشروع ما، مما يُسهّل تحقيقه. من أمثلة الموافقة السلبية رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض وقف إطلاق النار بسبب استخدام أحد أعضائه لحق النقض (الفيتو). هذا الإجراء، أو التقاعس، يُمثّل موافقةً سلبية على استمرار مذبحة الشعب الفلسطيني وتدمير أراضيه.
مثال آخر هو عندما يرفض مجلس إدارة مؤسسة تعليم عالٍ إمكانية التصويت على إدانة تدمير الجامعات وقتل أساتذتها. هذا يُمثّل موافقةً سلبيةً على السحق المستمر للنظام التعليمي الفلسطيني والعالم الأكاديمي.
الموافقة النشطة تتضمن الموافقة المباشرة على المشروع، وبالتالي دعم تنفيذه. رؤساء الدول يوافقون بشكل نشط عندما يصطفّون في القدس المحتلة للتأكيد على حق إسرائيل غير المشروط في الدفاع عن نفسها. الحكومات توافق بشكل نشط عندما ترسل كميات هائلة من الأسلحة والقنابل والطائرات إلى إسرائيل، مما يدعم فعليًا تنفيذ أعمال انتقامية بلا حدود.
استمر هذا الدعم النشط حتى بعد أن اعترفت محكمة العدل الدولية بوجود خطر حقيقي للإبادة الجماعية، على الرغم من أن الدعم تحوّل بالنسبة للبعض من الموافقة النشطة إلى الموافقة السلبية دون مقاطعة إرسال الأسلحة.
إلى جانب مجرد الموافقة، منعت بعض الدول الغربية بنشاط المدافعين عن حق الفلسطينيين في العيش بكرامة، أو حتى مجرد العيش، من التعبير عن آرائهم. ويشمل ذلك اتهامهم بالتحريض على الكراهية والترويج للإرهاب، واعتقالهم في الجامعات، أو منعهم من دخول الأراضي الأوروبية.
تأطير الصراع
يساعدنا الكتاب على الإجابة عن سؤال مهم يتعلق بشكل عام بالصراعات: كيف تم التحكّم في تأطير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وما هي عواقب ذلك؟
يُسهم التأطير في تأجيج الصراع واستمراره، كما يساعد على اتّساعه وانخراط أطراف أخرى فيه.
لقد تم التحكّم في صياغة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بدقة، وهي العملية التي وُصفت بأنها لغة الاتصالات الحكومية والعسكرية الإسرائيلية، والمعروفة باسم “هاسبارا”، والتي نُظر إليها نظريًا على أنها سلاح حرب.
إن وصف الصراع بأنه “حرب إسرائيل وحماس” أمر مُضلّل، لأنه يتجاهل التاريخ الأطول للصراع والحصار الشامل الذي يستهدف جميع سكان غزة.
تُعتبر الهاسبارا أداة استراتيجية تسعى لتشكيل الرأي العام العالمي وتوجيهه لصالح إسرائيل، من خلال نشر المعلومات الإيجابية، وتقديم السرد الإسرائيلي للأحداث، ومواجهة ما تعتبره “دعاية سلبية” أو “نزع شرعية” عن إسرائيل. تتضمّن هذه الجهود استخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، بما في ذلك حملات وسائل التواصل الاجتماعي، وتدريب الطلاب والنشطاء ليكونوا مؤيدين لإسرائيل في الجامعات.
يهدف هذا التأطير المتحكَّم فيه إلى إضفاء الشرعية على العمليات العسكرية وتشويه الانتقادات. وقد جرى هذا التحكم، وما يترتب عليه من عواقب، من خلال عدد من الآليات التي أوردها الكتاب وشرحها بالتفصيل:
1- فرض نقطة بداية سردية:
غالبًا ما يبدأ السرد السائد، وخاصة في وسائل الإعلام الغربية، الجدول الزمني للصراع الحالي بالهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يمحو أو يقلل فعليًا من “ستة وخمسين عامًا من الاحتلال الخانق والعنف المستمر” – على حدّ قول الكاتب.
هذه “النظرة غير التاريخية” تصوّر العنف الذي ارتكبته حماس على أنه “وحشية محضة”، غير عقلانية وغير متوقعة، مما يؤدي إلى نزع الصفة الإنسانية عن أعضائها، وبالتالي عن جميع الفلسطينيين. كما يسمح للدولة الإسرائيلية بالتنصل من المسؤولية عن نشوء الأحداث، متجاهلةً عقودًا من القمع، وخنق الشعب الفلسطيني، والاستراتيجيات التي عززت حتى منظمات مثل حماس.
2- التعاطف الانتقائي:
نقلت وسائل الإعلام قصصًا عن رهائن إسرائيليين محرَّرين، بينما أهملت المدنيين الفلسطينيين المفرَج عنهم من السجون الإسرائيلية بعد الإذلال والتعذيب. ركّزت على مخاوف الأطفال الإسرائيليين، بينما تجاهلت معاناة أطفال غزة الذين لا يملكون مأوى.
واكبت ذلك اتهامات باستخدام المقاومة “دروعًا بشرية”. وغالبًا ما يُبرر تدمير المستشفيات والمدارس بأن المنظمات الفلسطينية تستخدم النساء والأطفال كـ”دروع بشرية”. ومع ذلك، لم تجد التحقيقات التي أُجريت في عامَي 2009 و2014 أي أساس تجريبي لهذا الاتهام، في حين تم توثيق استخدام جيش الدفاع الإسرائيلي نفسه للمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، كدروع بشرية.
تزعم إسرائيل أن جيشها هو “الجيش الأكثر أخلاقية في العالم”، مستشهدة بالتحذيرات المسبقة والمنشورات والممرات الإنسانية. ومع ذلك، تكشف أدلة كثيرة – بما في ذلك مقاطع فيديو لأفراد عسكريين – عن أعمال عنف وإذلال وإهانة، مثل تجريد النساء من ملابسهن، وإجبار الرجال على إعلان أنفسهم “عبيدًا”، وتقييد مدير مستشفى كالكلب. إن اكتشاف مقابر جماعية عليها علامات تعذيب وأيدٍ مقيّدة يدحض هذا الادعاء بشكل أكبر.
3- نزع الصفة الإنسانية عن الخصم:
أعلن القادة الإسرائيليون والشخصيات العسكرية علنًا أنه “لا يوجد أبرياء” في غزة، وأشاروا إلى الفلسطينيين باعتبارهم “حيوانات بشرية”، مبرّرين الحرب بـ “عدم وجود كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود”. كما اعترف الجنود بـ”حرية التصرف الكاملة”، حيث “يُسمح بإطلاق النار على الجميع: فتاة صغيرة، امرأة عجوز”، ويُشتبه في أن كل رجل يتراوح عمره بين السادسة عشرة والخمسين إرهابي.
تم نزع الصفة الإنسانية من خلال اللغة. فقد قامت التقارير الإخبارية بإضفاء الصفة الإنسانية على الإسرائيليين أكثر من الفلسطينيين. فعلى سبيل المثال، غطّت “نجاح” تحرير أربعة رهائن إسرائيليين على نطاق واسع، مع ذكر ضئيل للمئات من الضحايا الفلسطينيين في العملية نفسها. وفي الصحف الأمريكية الرئيسية، استُخدمت كلمات مثل “مروّع” و”مجزرة” بشكل غير متوازن لوصف الوفيات الإسرائيلية مقارنة بالوفيات الفلسطينية.
4- الرقابة على المصطلحات:
أفادت التقارير أن محرّري بعض المنافذ الإعلامية الكبرى أصدروا تعليمات للصحفيين بتقييد استخدام مصطلحات مثل “الإبادة الجماعية” و”التطهير العرقي”، وتجنّب “مخيمات اللاجئين” و”الأراضي المحتلة”، والإشارة إلى “فلسطين” بشكل غير متكرر. كما نصحوا باستبدال الكلمات “العاطفية” مثل “مجزرة” بأوصاف واقعية للوفيات الفلسطينية.
5- التشكيك في أرقام الضحايا الفلسطينيين:
كثيرًا ما يصف الصحفيون أعداد القتلى الفلسطينيين بعبارات مثل “وفقًا لوزارة الصحة في غزة” أو “وزارة الصحة التي تديرها حماس”، وهو معيار مزدوج لا ينطبق على البيانات الإسرائيلية. ويُعد هذا التشكيك مثيرًا للسخرية، حيث من المرجّح أن تكون أعداد الوفيات الفلسطينية أقل من التقديرات الرسمية بسبب وجود جثث تحت الأنقاض، أو الوفيات الناجمة عن مشاكل طبية سببها الحصار ونقص الرعاية.
6- اقتران النقد بمعاداة السامية:
غالبًا ما يتم دمج انتقاد السياسة الإسرائيلية أو الصهيونية مع معاداة السامية، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة. وقد أدان الطبيب الفرنسي في كتابه المذكور، ومنظمات حقوق الإنسان، هذا الاستغلال لتعريف معاداة السامية، كما انتقد هذا الخلط عدد من العلماء والمنظمات اليهودية.
العواقب والتداعيات
يسهّل السرد المسيطر عليه “الموافقة على إبادة غزة”، سواء بشكل سلبي أو إيجابي، ويؤدي إلى قمع حرية التعبير، وحظر الفعاليات المؤيدة للفلسطينيين، والرقابة الأكاديمية، والرقابة الذاتية في الدول الغربية.
يواجه الباحثون والمعلمون والطلاب ضغوطًا، وعقوبات تأديبية، وحتى اعتقالات، بسبب التحدث علنًا. وتتدخل الحكومات في المؤسسات الأكاديمية، ويُستخدم جهاز الشرطة لفرض المواقف والآراء.
يؤدي هذا التأطير أيضًا إلى عدم مساواة عميقة في القيمة المنسوبة إلى حياة الإسرائيليين والفلسطينيين. غالبًا ما يُنظر إلى موت المدنيين الفلسطينيين على أنه “أضرار جانبية”، في حين أن معدل وفيات الأطفال أعلى بـ1850 مرة بين الفلسطينيين مقارنة بالإسرائيليين. ومع ذلك، فإن الحداد على الفلسطينيين أقل بكثير مقارنة بالحداد على الإسرائيليين. وهذا ما يجعل بعض الأرواح “يجب الحداد عليها”، بينما لا تُمنح أرواح أخرى القيمة ذاتها، مما يسمح بتبرير وفاتهم على أنها “ضرورية لحماية أرواح الأحياء”.
يساعدنا كتاب ديدييه فاسان في فهم كيف تمّت الموافقة في الغرب على الإبادة في غزة من خلال تأطير الصراع، لكن ما يستحق أن نبذل فيه جهدًا هو: كيف تمّت الموافقة على الإبادة في عالمنا العربي؟
إن “الموافقة التبريرية” التي قامت بها العديد من النخب الثقافية والإعلامية والسياسية والدينية، لها وظائف ومهام متعددة: استفاد منها الحُكّام لضمان مصالحهم واستمرارهم في السلطة، وبرّروا بها مواقفهم المتخاذلة، كما استُخدمت لتسويغ عجزنا وعدم قدرتنا على الفعل، ورأى فيها البعض سبيلًا لتسوية صراعاتنا السياسية والثقافية والدينية التي لم تُحسم لعقود، أو حتى لضمان مصالحهم الذاتية في البقاء في دور أو منصب أو وظيفة… إلخ.
مأساة غزة لن تكون الأخيرة؛ فقد سبقتها إبادات، وواكبتها أخرى – كما في السودان الآن – وسيتلوها الكثير، لأن العوامل الهيكلية التي تُنتج مثل هذه الممارسات لا تزال قائمة وتتفاقم. ولا أحد محصّن منها، لأن هذه العوامل الهيكلية لم ننجح في التعامل معها، رغم ما يبدو من ارتقاء البشرية وما أنتجته من قانون دولي إنساني وتنظيمات دولية.