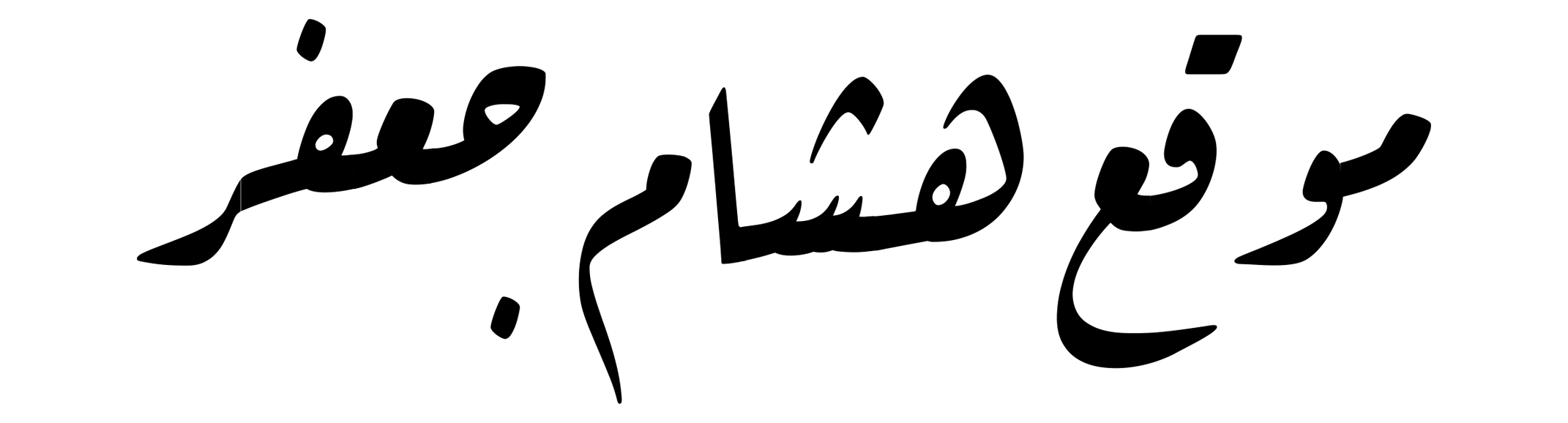من المفترض أن يساهم هذا الجهد البحثي في تقديم إطار تحليلي “أكثر تفسيرية” لفهم الإبادة الجماعية في غزة، والتي لا يجب النظر إليها كحدث معزول بل كنتيجة معقدة متجذرة في قوى تاريخية واقتصادية وسياسية وأيديولوجية وتكنولوجية مترابطة.
من المتوقع أن يدمج هذا الإطار عدسات تحليلية متعددة لاستكشاف الأبعاد والتداعيات المختلفة للإبادة الجماعية، مع إدراك كافٍ للظواهر الجديدة التي صاحبت هذا النوع من الإبادة.
أولًا: تقديم
في تصريح للمفوضية الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، في 15 سبتمبر/ أيلول 2025م، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، ذكرت ما يلي:
* إن الأرقام المتوفرة تفيد بأن عدد القتلى في صفوف الفلسطينيين تجاوز 65 ألف شخص، 75% منهم من النساء والأطفال.
* أشارت إلى أن تقديرات بعض الخبراء المستقلين ترفع عدد الشهداء إلى 680 ألفًا، بينهم 380 ألفًا دون الخامسة من العمر، وشددت على ضرورة أخذ هذه الأرقام على محمل الجد.
* أوضحت أن قوات الاحتلال قتلت خلال 710 يومًا من الحرب 1581 عاملًا صحيًا و252 صحفيًا و346 موظفًا أمميًا.
* أكدت اعتقال نحو 10 آلاف فلسطيني، من بينهم مرضى وأطباء، وتعرض الكثير منهم للتعذيب وسوء المعاملة والاغتصاب، وقُتل منهم 75 أسيرًا داخل السجون.
* ووصفت الوضع في الضفة الغربية بأنه “خطير”، مشيرة إلى أن الاحتلال قتل أكثر من ألف فلسطيني خلال الفترة نفسها، بينهم 212 طفلًا، وأجبر أكثر من 40 ألف شخص على النزوح القسري.
شارك في المؤتمر أيضًا كل من المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير، إيرين خان، التي تحدثت عن مخاطر العمل الصحفي في غزة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل، جورج كاتروغالوس، الذي تحدث عن امتداد الهجمات الإسرائيلية إلى دول مجاورة. وقد طالب جميع المقررين المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف ما وصفوه بـ “الإبادة الجماعية”.
وفي اليوم الأخير من شهر أغسطس/آب عام 2025م، أقرت الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، وهي هيئة علمية تضم أكثر من 500 عضو، قرارًا بتأييد 86% من المصوتين، وخلصت إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. يدرس هؤلاء الباحثون الإبادة الجماعية بشكل احترافي، ويبحثون فيها، وينظرون إليها نظريًا، وينشرون عنها في مجلات محكمة.
لن أسترسل كثيرًا في ذكر التقارير الحقوقية والتصريحات والبيانات الصحفية للمنظمات الدولية بشأن التأكيد على أن ما يقوم به الكيان الصهيوني في غزة هو إبادة جماعية؛ فما يعنينا هو مدى توفر أركان تعريف الإبادة الجماعية -كما وردت في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (ديسمبر ١٩٤٨م)، بما سمح لهم بإطلاق هذا الحكم على أفعال إسرائيل.
خلصت اللجنة الأممية، التي تُعرف باسم “لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة”، في تقريرها الصادر 16 سبتمبر/ أيلول 2025م، إلى أن إسرائيل ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة التي تُصنف ضمن الإبادة الجماعية، وهي:
* القتل
* التسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير.
* فرض ظروف معيشية تهدف إلى التدمير الكامل أو الجزئي للفلسطينيين.
* فرض تدابير لمنع الإنجاب.
كما أشار التقرير إلى أن كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ، حرَّضوا على هذه الأفعال. أما الرابطة الدولية لعلماء الإبادة فقد توصل أعضاؤها إلى هذا الاستنتاج من خلال دراستهم بدقة المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، التي وقّعت عليها إسرائيل.
تُعرّف هذه المادة الإبادة الجماعية على النحو التالي: “في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيًا من الأفعال التالية المرتكبة بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه، كليًا أو جزئيًا:
(أ) قتل أعضاء الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بأعضاء الجماعة.
(ج) فرض ظروف معيشية متعمدة على الجماعة من شأنها أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليًّا أو جزئيًّا.
(د) فرض التدابير الرامية إلى منع المواليد داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال الجماعة قسرًا إلى جماعة أخرى”.
يعتقد الكثيرون أن الإبادة الجماعية تتمثل في قتل جميع أفراد جماعة ما تقريبًا. مع ذلك، يوضح هذا التعريف القانوني التقني إمكانية إبادة شعب ما حتى لو نجا عدد كبير من أعضائه. الإبادة الجماعية، كما هي مُعرّفة هنا، تتعلق بغرض العنف أكثر من جسامته. إذا قتلتَ أشخاصًا بسبب هويتهم واعتراضك على وجودهم، فلا يشترط قتل عدد كبير منهم حتى تُعتبر إبادة جماعية.
لذلك، فإن الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية أعلنت أن: “سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تُطابق التعريف القانوني للإبادة الجماعية الوارد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” (1948م)، وأكدت: “أن سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقًا لما يُعرّفه القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
الخطير في غزة تحديدًا، وقد استمرت الإبادة فيها ما يقرب من 24 شهرًا وما يزيد على 700 يومًا، هو التطبيع مع العنف الممنهج.
ويشير التطبيع، في سياق الإبادة الجماعية، إلى العملية التي اعتاد بموجبها النظام الدولي والمجتمعات، لا سيَّما العربية، على العنف المروع والتدمير المنهجي الذي يحدث هناك، مما يسمح للحياة بالاستمرار كالمعتاد رغم هذه الفظائع، ويجعل الإبادة الجماعية المستمرة، مع التجويع، وقتل الأطفال والنساء، وقطع المياه والكهرباء، وقصف المستشفيات والمدارس ودور العبادة، وتدمير أحياء وعائلات بأكملها، تبدو كلها وكأنها أمر طبيعي يجري في خلفية الحياة الاعتيادية.
وهذا يدفعنا إلى التساؤل: هل يمكن اعتبار ما يحدث في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023م مؤشرًا على مستقبل يتعايش فيه العالم مع المآسي الناجمة عن الصراعات والحروب؟ وهل أصبح القتل الجماعي جزءًا لا يتجزأ من واقعنا المشترك ومستقبلنا؟
ترتبط الإبادة الجماعية في غزة بظاهرة أوسع نطاقًا تتمثل في القتل الجماعي الذي لوحظ في صراعات أخرى لا تزال مستعرة (اليمن والسودان ودول الساحل الإفريقي والمكسيك وأوكرانيا…). يُظهر ذلك أن العنف المسلح اليوم يأخذ أشكالًا متنوعة، سواء كانت حروبًا تقليدية بين دول، أو حروبًا أهلية، أو عنفًا مرتبطًا بالجريمة المنظمة. وتشير هذه الأشكال مجتمعة إلى أن القتل الجماعي أصبح ظاهرة عالمية. ورغم الزيادة الهائلة في قتل المدنيين والنزوح القسري المرتبط بالنزاعات المسلحة عالميًّا، فإن الحماية الممنوحة لهم تتراجع. ويرسم الأمين العام للأمم المتحدة صورة قاتمة في تقريره السنوي الصادر في مايو/أيار الماضي.
وفي الوقت نفسه، أصبحت الوسائل الدولية المعتادة لحل النزاعات غير فعالة أكثر من ذي قبل. ولذلك، من الضروري تسجيل التغييرات المهمة في حالات النزاع بصورة منهجية وعاجلة، وإعادة ضبط أساليب حماية السكان المدنيين على هذا الأساس.
لا تحظى الهجمات واسعة النطاق على المدنيين في الحروب الدائرة في قطاع غزة وأوكرانيا والسودان وغيرها باهتمام دولي إلا نادرًا. ومع ذلك، فإنها تُشير إلى تطور مفزع، فقد ازداد عدد الصراعات العنيفة وشدتها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
ففي عام 2023م، شهد العالم صراعات عنيفة أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية، كما ارتفعت معدلات القتلى الإجمالية. وبين عامي 2021 و2024م، كانت الأرقام هي العليا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994م. وباستثناء الإبادة الجماعية، يُمثل هذا أعلى عدد من القتلى في الصراعات العنيفة منذ بدء جمع البيانات عام 1989م.
في الواقع، فإن عدد قتلى النزاعات في السنوات الأخيرة أعلى بكثير مما كان عليه في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، لكن تظل غزة نقلة نوعية كبرى عما سبقها، مما يكشف عن بُعد جديد في تأثير النزاعات العنيفة في المدنيين، سيكون له ما بعده.
ثانيًا: منهج النظر إلى الإبادة في غزة
من المفترض أن يساهم هذا الجهد البحثي في تقديم إطار تحليلي “أكثر تفسيرية” لفهم الإبادة الجماعية في غزة، والتي لا يجب النظر إليها كحدث معزول بل كنتيجة معقدة متجذرة في قوى تاريخية واقتصادية وسياسية وأيديولوجية وتكنولوجية مترابطة.
من المتوقع أن يدمج هذا الإطار عدسات تحليلية متعددة لاستكشاف الأبعاد والتداعيات المختلفة للإبادة الجماعية، مع إدراك كافٍ للظواهر الجديدة التي صاحبت هذا النوع من الإبادة.
تصف التقارير الحقوقية والتحقيقات الاستقصائية الصحفية أشكالًا متعددة من العنف الذي استخدمته إسرائيل في حربها الجارية على غزة، ووصفتها بأنها غير مسبوقة من حيث النطاق والمنهج والأدوات والأساليب. وعلي الرغم من ذلك؛ فإننا يجب أن ننشغل بالعوامل الهيكلية والبنى التي دفعت لإدامة هذه المحرقة واستمرارها، على الرغم من أنها ولأول مرة في التاريخ يتم بثها على الهواء مباشرة.
هذه البنى والهياكل تعني استمرار القدرة على الإبادة في مناطق أخرى من العالم، وضد مجموعات بشرية مختلفة.
في الفصل الأخير من كتابي “عالم ترامب“ المتوقع صدوره أكتوبر/تشرين الأول 2025م عن دار روافد بالقاهرة، والذي خصصته لفهم وتحليل الإبادة الجماعية في غزة؛ قدمت اقترابات متعددة مترابطة تسلط الضوء على طبيعتها المعقدة، بالاستعانة بالعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأيديولوجية، وكذا التكنولوجية.
يستكشف الفصل جوانب مختلفة من الإبادة الجماعية، ويبحث في كيفية التطبيع معها من خلال التكيف المجتمعي والمعرفي، ويحلل الحوافز المالية وتواطؤ الشركات التي يمكن أن جعلت الإبادة الجماعية “مربحة”، ويشير إلى العوامل التي أدت إلى الفشل العالمي في التدخل الفعال لوقفها. علاوة على ذلك، يناقش المصالح الجيوسياسية، والشعور بالذنب التاريخي لدى بعض الدول الأوربية خاصة ألمانيا، والتحيزات المنهجية، بما في ذلك الإسلاموفوبيا والعنصرية ضد العرب، التي تُسهم في التقاعس الدولي.
كما يتناول الفصل دور الرأسمالية وشركات الأسلحة في إدامة الصراع، وكيف يمكن لمحرقة غزة أن تُعيد تشكيل مستقبلنا الإنساني المشترك فيما يتعلق بالقتل الجماعي. فعلى حد قول الكاتب البرازيلي فراي بيتو، فإن: “القرن الواحد والعشرين؛ له ما قبل غزة وما بعدها”.
وعلى الرغم من أن الفصل قد وضع محرقة غزة في سياق إنساني وتاريخي ممتد، وبحث في البنى والهياكل التي تضمن إدامة المحرقة واستمرارها، وربطها بسياقات فكرية أوسع مثل: أزمة الحداثة ونهاية التاريخ وتقويض الديموقراطية وعودة حروب الهوية …، إلا إنه لم يتطرق بشكل كاف إلى طبيعة المشروع الصهيوني الحالي، والذي اعتقد أنه مختلف كليًّا عما سبقه مما يستدعي مزيدًا من البحث والتقصي.
مفاهيم أساسية
استند الفصل إلى عدد من المفاهيم النظرية التي تنتمي إلى حقول معرفية متعددة؛ ضمانًا لفهم الظواهر التي لا يبدو وجود رابط بينها، ووصولًا إلى أن نكون “أكثر تفسيرية” -وفق ما تعلمناه من أستاذنا عبد الوهاب المسيري رحمه الله.
أبرز هذه المفاهيم:
١- الرأسمالية آكلة لحوم البشر (Cannibal Capitalism): هو مصطلح استخدمته الفيلسوفة والمنظرة الماركسية النسوية نانسي فريزر لوصف طبيعة الرأسمالية المعاصرة، وخاصةً في مرحلتها النيوليبرالية.ريشير المصطلح إلى فكرة أن النظام الرأسمالي لا يكتفي باستغلال العمالة المأجورة فقط، بل يتغذى ويلتهم بشكل منهجي الجوانب غير الاقتصادية للمجتمع الذي يعتمد عليها في استمراره.
تجادل فريزر في كتابها “الرأسمالية آكلة لحوم البشر: كيف يبتلع نظامنا الديمقراطية، الرعاية، والكوكب – وما الذي يمكننا فعله حيال ذلك؟” كيف أن النظام الرأسمالي ليس نظامًا اقتصاديًا خالصًا، بل هو نظام اجتماعي أوسع يعتمد على أربعة أبعاد رئيسية:
* الاقتصاد: حيث يتم استغلال العمالة المأجورة.
* التربية الاجتماعية (Social Reproduction): وتشمل العمل غير المأجور للعناية وتربية الأجيال الجديدة، مثل العمل المنزلي ورعاية الأطفال وكبار السن. ترى فريزر أن الرأسمالية تستنزف هذا البعد دون أن تدفع مقابله.
* البيئة: حيث يستغل النظام الرأسمالي الموارد الطبيعية بشكل جائر دون الاهتمام بالعواقب البيئية، مما يؤدي إلى تدمير الكوكب الذي يعتبر شرطًا أساسيًا لوجوده.
* السياسة: حيث تبتلع الرأسمالية الديمقراطية عن طريق تفريغ المؤسسات السياسية من محتواها وتحويلها لخدمة مصالح السوق والشركات، مما يقلل من قدرة المجتمعات على تنظيم نفسها ومقاومة هذا الاستنزاف.
بهذا المعنى، فإن الرأسمالية “آكلة لحوم البشر” لا تكتفي بـ “أكل” أعدائها، بل تلتهم بشكل متزايد شروط بقائها الخاصة، مما يدفع المجتمع نحو أزمات متعددة ومتشابكة في مجالات البيئة، والرعاية، والسياسة، والاقتصاد.
هذا المفهوم يمثل توسيعًا للنظرية الماركسية التقليدية التي ركزت على الاستغلال الاقتصادي، ليشمل أشكالًا أخرى من الاستنزاف تعاني منها جميع فئات المجتمع.
٢- تسليع المعاناة: يُشير مصطلح تسليع المعاناة (Commodification of Suffering) إلى تحويل المعاناة الإنسانية، سواء كانت فردية أو جماعية، إلى سلعة قابلة للتسويق والبيع والشراء. تحدث هذه العملية عندما تُستخدم المعاناة كأداة لجني الأرباح، سواء كانت مادية أو معنوية، بدلًا من أن تكون دافعًا للمساعدة والتعاطف الخالص.
ومن جوانب تسليع المعاناة
* المحتوى الإعلامي: تظهر في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص، حيث يتم عرض قصص المعاناة الشخصية للاجئين أو ضحايا الكوارث أو الحروب بطريقة تثير المشاعر القوية بهدف جذب المشاهدات؛ وبالتالي تحقيق أرباح من الإعلانات أو التبرعات. وفي هذه الحالة، يصبح الألم الإنساني مجرد مادة خام لتوليد المحتوى.
* الصناعات الخيرية: تتحول المعاناة إلى مصدر دخل لبعض المنظمات الخيرية والإنسانية التي قد تنفق مبالغ ضخمة على التسويق وجمع التبرعات، مما يثير تساؤلات حول مقدار ما يصل فعليًا إلى المتضررين.
ترتبط عملية التسليع بمفهوم “رأسمالية الموت“ Thana Capitalism -الذي صاغه ماكسيميليانو إي. كورستانجي، عالم الاجتماع الأرجنتيني- وهو يصف مرحلة من الرأسمالية، حيث يكون الموت سلعة أساسية للتبادل والاستهلاك، ويتم تناول المعاناة الإنسانية واستهلاكها بصريًّا للترفيه وتعزيز الأنا.
يتضمن ذلك زيارات لمواقع الموت الجماعي والمعاناة، والتي يُعاد تدويرها ويستهلكها جمهور عالمي بصريًّا، مما يخلق “اقتصادًا منغمسًا في الموت”، وهي مرحلة جديدة من الرأسمالية حيث يصبح موت الآخرين والمعاناة البشرية سلعة رئيسة يتم تبادلها واستهلاكها.
يُجادل كورستانجي بأن طبقة ناشئة من “الباحثين عن مشاهد الموت” تستهلك هذه المشاهد الكئيبة ليس بالضرورة بدافع التعاطف، بل غالبًا لتعزيز شعورهم بالحياة والتفوق، أو للحصول على الإثارة. يصبح موت “الآخر” (أولئك الذين يعانون) إثباتًا لبقاء المرء ومكانته في نظام لا يفوز فيه إلا الأصلح.
يقوم هذا النوع من الاستهلاك بتعزيز شكل من أشكال الداروينية الاجتماعية، حيث يشعر الأفراد بأنهم في “سباق” دائم من أجل البقاء. إن مشاهدة معاناة الآخرين، لا سيما من خلال الوسائط البصرية، قد تؤدي إلى تعزيز نرجسي لسلامة الفرد ونجاحه، بدلًا من ارتباط حقيقي أو رغبة في المساعدة.
إن استهلاك معاناة “الآخرين” يسمح للأفراد (غالبًا من الشمال العالمي) بتعزيز شعورهم بالتفوق والامتياز والمكانة الفريدة. هذه “السعادة المرضية” متجذرة في الداروينية الاجتماعية، حيث إن كون المرء “ناجيًا” يدل على القوة الأخلاقية والاستثنائية.
تستغل السلطات الحاكمة في كل مكان “ثقافة الخوف” كأداة تأديبية (مثلًا، من الإرهاب، أو تغير المناخ، أو الجريمة، أو عدم الاستقرار والفوضى، وأخيرًا التجويع في غزة) للسيطرة على الجماهير وتبرير سياسات قد تُرفض لولا ذلك، مثل زيادة المراقبة والمنع من التظاهر أو إجراءات التقشف. هذا التهويل يصرف الانتباه عن المشكلات الهيكلية التي تُسببها سياساتهم.
في جوهره، يُحول تسليع المعاناة المشكلات المجتمعية المعقدة إلى سرديات قابلة للاستهلاك، والتي بدلا من تعزيز الفهم النقدي أو دفع التغيير النظامي، تُعزز رؤية عالمية نرجسية ومتعالية على الذات، وتُديم أوجه عدم المساواة وديناميكيات القوة التي تولد المعاناة في المقام الأول.
٣- سياسة الموت: مفهوم “سياسة الموت” (Necropolitics)، أو “سلطة الحياة والموت”، هو مفهوم فلسفي وسياسي طوره الفيلسوف الكاميروني أشيل مبيمبي، وهو يوسع مفهوم “السياسة الحيوية” (Biopolitics) لميشيل فوكو.
وبينما يرى فوكو أن السلطة الحديثة تعمل من خلال “جعل الناس يعيشون وتركهم يموتون” (to make live and to let die)، أي أنها تركز على تنظيم الحياة وإدارتها (مثل الصحة العامة، التعداد السكاني، إلخ)، يجادل مبيمبي بأن هناك أشكالًا من السلطة تتجاوز ذلك وتتأسس بشكل مباشر على القدرة على تحديد من يجب أن يموت ومن يمكن أن يعيش.
بعبارة أخرى، “سياسة الموت” هي ممارسة السلطة التي تتمحور حول التحكم في الموت وتوزيع أدواته، مما يؤدي إلى إنشاء “عوالم موت” (death-worlds) حيث يتم وضع مجموعات معينة من الناس في حالة من “الموت الحي” (living death)، أي أن حياتهم تُعتبر قابلة للاستنزاف أو التضحية بها في أي لحظة.
ويحدد مبيمبي أبعادًا متعددة لهذه السياسة:
* السيادة كممارسة للموت: يرى مبيمبي أن التعبير النهائي عن السيادة ليس فقط في القدرة على إقامة القوانين، بل في القدرة على قتل الأعداء أو السماح لهم بالعيش؛ فالسيادة تعني التحكم المطلق في الموت.
* استعمار ما بعد الحداثة: يطبق مبيمبي هذا المفهوم على حالات الاستعمار الجديد وما بعد الاستعمار، حيث تستخدم الدول القوية آليات العنف والإبادة المنظمة والحروب الأهلية والاحتلال لإخضاع السكان وتجريدهم من إنسانيتهم. هذه الآليات تخلق مناطق “خارج القانون” حيث يمكن قتل الناس دون عقاب.
* العنصرية كأداة: يربط مبيمبي سياسة الموت بالعنصرية، حيث تصبح العنصرية الأداة التي تسمح للدولة بتحديد من هم “الآخرون” الذين لا تستحق حياتهم الحماية. إنها تبرر العنف والقتل من خلال تجريد الضحايا من صفة الإنسانية.
* الموت الحي: يشير هذا البعد إلى حالات مثل اللاجئين، أو سكان المخيمات، أو المجموعات المستضعفة التي تعيش في ظروف بائسة، حيث لا يتم قتلهم بالضرورة بشكل مباشر، ولكن حياتهم لا تُحترم، وتُترك عرضة للمرض، والجوع، والعنف، مما يجعلهم في حالة من “الموت الحي”.
بشكل عام، يمثل مفهوم “سياسة الموت” نقدًا جذريًا للسياسة الحديثة، ويوضح كيف أن العنف ليس مجرد “أداة” عرضية للسلطة، بل هو جوهرها في العديد من السياقات المعاصرة، وخاصةً في مناطق النزاع، ومناطق ما بعد الاستعمار، والمخيمات، والمناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة.
٣- عقيدة الإبادة أو مبدأ الإبادة الذي صاغه تشاينبوك في كتابه “عقيدة الإبادة: منع الإبادة الجماعية، إسرائيل، غزة والغرب“: تمثل هذه العقيدة أساليب الحرب المدمرة في القرن الحادي والعشرين، حيث تطبق التكتيكات العسكرية القديمة جنبًا إلى جنب مع التقنيات المتقدمة. إنها تهدف إلى التدمير الكامل لأي شيء بحيث لا يبقى منه شيء، بما في ذلك الدمار المادي (البنية التحتية، والمراكز الحضرية، والمباني العامة، والمستشفيات)، والقضاء على كل من المقاتلين وغير المقاتلين، والبيئة بأكملها.
ويشمل ذلك أيضًا محوًا للمعاني والرموز وإزالة شيء من الذاكرة، مثل المتاحف والمكتبات والمؤسسات الثقافية، وهو ما أطلق عليه المحامي البولندي -أبو اتفاقية الإبادة- رافائيل ليمكين (١٩٠٠-١٩٥٨م): “الإبادة الثقافية”.
٤- الإبادة الخوارزمية: الإبادة الخوارزمية “Algocide”، هو مصطلح جديد يجمع بين كلمتي algorithm (خوارزمية) وgenocide (إبادة جماعية)، للإشارة إلى الاستخدام المنهجي للخوارزميات والذكاء الاصطناعي في شن أعمال إبادة جماعية ضد المدنيين. وتتميز الإبادة الجماعية الخوارزمية، أو “الإبادة الخوارزمية”، بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة للغاية لتسهيل عملية التدمير.
يربط هذا المفهوم –الذي صاغه أيضًا بالتطبيق على غزة دان تشاينبوك في كتابه عن سقوط إسرائيل الصادر العام الماضي- بين الذكاء الاصطناعي والفظائع البشرية. وتشمل الخصائص والميزات الرئيسية للإبادة الخوارزمية ما يلي:
أ- التيسير التكنولوجي:
يتم تمكينها من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، مما يجعل عملية التدمير كثيفة رأس المال وسريعة بشكل مذهل وفعالة بشكل قاتل.
وعلى الرغم من استخدام مفرط للتكنولوجيا المتقدمة، فإن ما يقرب من نصف الذخائر الجوية-الأرضية المستخدمة في غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، كان “قنابل غبية” غير موجهة، مما يؤكد التركيز على الضرر الواسع النطاق بدلا من الدقة، مما يشكل تهديدا أكبر للمدنيين في المناطق المكتظة بالسكان.
ب- عملية النخر:
تسهل الإبادة الخوارزمية “عملية النخر”. و”النخر” لغةً يعني حالة من الفساد أو التحلل الذي يضرب شيئا ما سواء كان حيًّا (أنسجة)، أو جامدًا: (خشبًا، عظمًا، حجرًا).
يهدف النخر إلى تحويل العالم الحي إلى عالم الموت، مما يتطلب النزوح والسلب والتدمير. وهذا يتضمن تحويل المنازل والمدارس والجامعات إلى أنقاض وخرائب، وتلويث البيئة (الماء والهواء والأرض)؛ لإجبار الناس على المغادرة. ويمكنه استهداف جوانب مختلفة من المجتمع، بما في ذلك سياسته وثقافته واقتصاده وسكانه وحتى بيئته.
ج- المسافة الأخلاقية وإزالة الإنسانية:
إن الطبيعة المجردة للحرب عالية التقنية، كما هو الحال في الإبادة الخوارزمية، يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات أقل أخلاقية؛ لأن العواقب الإنسانية تبدو بعيدة.
تتعزز هذه “المسافة الأخلاقية” من خلال عملية نفسية تسمى “الانقسام”، والتي تشجع على النظر إلى الأشخاص والمواقف بنظرة مانوية مطلقة (الأبيض والأسود، الخير والشر). يؤدي هذا إلى نزع الصفة الإنسانية عن “الآخر” وإضفاء صفة الشيطنة عليه، وتصويره على أنه “حيوان بشري”.
د- إضفاء الشرعية على الإبادة الجماعية:
في هذا الإطار الأخلاقي المشوه، يصبح محاربة “حيوان بشري” “ضرورة أخلاقية”. وإذا طبق مبدأ العقاب الجماعي، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي لإبادة الآلاف ليس مجرد ذريعة عسكرية، بل يشرعن على نحو مضلل كواجب أخلاقي، حيث يعتقد الجاني أنه “يفعل الخير بالقضاء على الشر”.
٥- دولة الجند والقطائع: صاغ عالم السياسة والاجتماع الأمريكي هارولد لاسويل هذا المفهوم في مقال مؤثر عام 1941م بعنوان “The Garrison State“. يشير هذا المفهوم إلى نوع من الدولة أو المجتمع حيث يصبح “المتخصصون في العنف” (أي النخبة العسكرية والأمنية) هم القوة المهيمنة، وتطغى الأولويات العسكرية والأمنية على جميع الاعتبارات الاجتماعية والسياسية الأخرى.
وفي التاريخ الإسلامي، فإن “دولة العسكر والجند والقطائع” تشير إلى فترة تاريخية اتسمت بتزايد نفوذ الجيش والقادة العسكريين، والذين كانوا يسيطرون على مساحات واسعة من الأراضي (القطائع) كوسيلة لتعزيز قوتهم الاقتصادية والسياسية، مما أدى في النهاية إلى ضعف سلطة الخلافة المركزية وظهور الدول المستقلة في الأطراف، مثل الدولة الطولونية.
هذا النوع من الدول يختلف عن الدولة العسكرية. فالأخيرة، تشير إلى نظام حكم تكون فيه السلطة السياسية والاقتصادية العليا بيد المؤسسة العسكرية أو القادة العسكريين. في هذا النوع من الدول، لا يقتصر دور الجيش على الدفاع عن الحدود، بل يتعداه إلى إدارة شؤون البلاد الداخلية والخارجية بشكل مباشر.
لقد تأثر لاسويل بتطور الحروب الجوية (كما حدث في الحرب العالمية الثانية) واعتقد أنها ستؤدي إلى انتشار التهديدات، و”تأميم المخاطر” من خلال مركزة السلطة مما يقلل الحريات الفردية لصالح الأمن القومي. وقد تم تطبيق هذا المفهوم على دول مختلفة في أوقات الصراع أو الاستقطاب الأمني الشديد، حيث تصبح الأولويات الأمنية هي المحرك الأساسي للمجتمع، بما يدفع لقبول هذا النمط من الحكم.
٦- مفهوم التقاطعية (Intersectionality): أو كما يُطلق عليه أحيانًا “التقاطع”، هو إطار تحليلي يُستخدم لفهم كيفية تفاعل أنظمة القهر والتمييز المختلفة مثل العنصرية، والتمييز على أساس الجنس، والطبقية، والميول الجنسية، والإعاقة، لخلق تجارب فريدة ومعقدة من التمييز والإقصاء لدى الأفراد أو المجموعات.
صاغت هذا المصطلح الناشطة والأكاديمية الحقوقية الأمريكية كيمبرلي كرينشو في عام 1989م. استخدمته في البداية لتسليط الضوء على فشل القوانين والتحليلات التقليدية في معالجة التمييز المزدوج أو المتعدد الذي تواجهه النساء السوداوات في الولايات المتحدة.
شرحت كرينشو أن المرأة السوداء لا تعاني فقط من التمييز على أساس كونها امرأة (التمييز على أساس الجنس) ولا تعاني فقط من التمييز على أساس كونها سوداء (العنصرية)، بل تعاني من نوع فريد من التمييز ينشأ من تقاطع هاتين الهويتين. هذا التقاطع ينتج عنه تجربة لا يمكن فهمها من خلال النظر إلى العنصرية أو التمييز الجنسي بمعزل عن الآخر.
ويُقدم المفهوم التقاطعي فهمًا أكثر شمولًا للظلم الاجتماعي من خلال:
* تجاوز النظرة الأحادية: يدحض فكرة أن التمييز يمكن فهمه من خلال بُعد واحد فقط. فبينما قد تواجه امرأة بيضاء تمييزًا جنسيًا، فإن تجربتها تختلف جذريًا عن تجربة امرأة فقيرة من أصول مهاجرة ومثليّة، حيث تتداخل أنظمة القهر (التمييز الجنسي، والطبقية، والعنصرية، والتمييز على أساس الميول الجنسية) لتشكل تجربتها الفريدة.
* تسليط الضوء على الفئات الأكثر تهميشًا: يُركز على الفئات التي غالبًا ما يتم تجاهلها في الحركات الاجتماعية التي تركز على قضية واحدة فقط. على سبيل المثال، في الحركات النسوية قد يتم إهمال تجارب النساء من الأقليات العرقية، وفي الحركات المناهضة للعنصرية قد يتم تجاهل قضايا النساء والرجال من مجتمع الميم.
* فهم الهوية المركبة: يُقر بأن هوية الإنسان ليست مجرد “مجموع” لهويات منفصلة، بل هي نتاج تفاعل هذه الهويات مع بعضها البعض ومع الأنظمة الاجتماعية.
بشكل عام، تدعو التقاطعية إلى تحليل شامل للعلاقات الاجتماعية والسلطة، وإلى تصميم سياسات وحلول أكثر عدالة وفعالية تأخذ في الاعتبار التعقيد الكامل لتجارب الأفراد.
هذه أهم المفاهيم التي استخدمتها في تحليل محرقة غزة ويمكن الرجوع إلى الفصل المرفق مع هذه الورقة للاستزادة من المفاهيم الأخرى، أما أبرز المداخل التي يمكن فهم وتحليل وتفسير إبادة غزة فهي ما يتم شرحه في القسم التالي.
مداخل خمسة:
أولًا: الرأسمالية واقتصاد الإبادة الجماعية: ويتم تقديم الإبادة الجماعية باعتبارها “مشروعًا مربحًا” للكيانات التجارية، مما يوضح كيف يمكن تحويل العنف والمعاناة إلى سلعة لتحقيق مكاسب اقتصادية؟
تستفيد الشركات الإسرائيلية والدولية، وخاصة في مجال التكنولوجيا العسكرية، من الصراع، حيث تستخدم غزة كـ “أرض اختبار للقتال” لأنظمة الأسلحة التي يتم تسويقها بعد ذلك للعملاء الدوليين.
لقد ساهمت الشركات والمؤسسات المالية، بما في ذلك شركات الدفاع وشركات التكنولوجيا وشركات البناء وموردي الطاقة وتجار التجزئة، في تمكين الاحتلال الإسرائيلي والحملة الحالية في غزة والاستفادة منها.
وتتضمن الجوانب الرئيسة لهذا الفهم ما يلي:
- التواطؤ الشركاتي: هناك تركيز كبير على “التواطؤ الشركاتي”، والذي يوصف بأنه “له تاريخ ممتد” ويشير هذا إلى أن العديد من الشركات والمؤسسات تلعب دورًا في تمكين الإبادة الجماعية أو الاستفادة منها بمرور الوقت.
- اقتصاد الموت والتسليع: يقدم التحليل فكرة “اقتصاد الموت” و”تسليع الإبادة الجماعية”، وخاصة في سياق غزة.
- المستفيدون والصناعات: إن أرباح الحرب التي تقع في جيب عدد محدود من الشركات ذات صلة بتحديد المستفيدين ماليًا من الصراع والإبادة الجماعية. ويعتبر تأثير صناعة الأسلحة على السياسة أيضًا أحد العوامل في هذا الفهم الاقتصادي.
- دمج القطاعات: إن دمج القطاعات وتكاملها جزء من كيفية تحقيق الربح من الإبادة الجماعية، مما يشير إلى أن الصناعات المختلفة قد تتشابك في الآليات الاقتصادية التي تدعم مثل هذه الفظائع.
ثالثًا: التحليل الاجتماعي والنفسي للتطبيع والتكيف مع الفعل الإبادي المستمر
يبحث هذا النهج في كيفية تطبيع الإبادة الجماعية من خلال “التباعد الاجتماعي”، و”التكيف المعرفي مع الإبادة الجماعية”، و”إسكات التضامن بالعقلانية” (كتم أنفاس التراحم بالعقلانية). كما يتناول تأثير ذلك على “المواطن العربي المنهك” الذي يواجه أولويات وضغوطات حياتية وسياسية هائلة.
وعلى الرغم من وجود عدد من الإصدارات التي ناقشت أسباب القبول الغربي للإبادة في غزة، إلا إنه فيما أعلم لم تتوفر دراسات كافية لمناقشة القبول الضمني لها في منطقتنا.
يسلط هذا الاقتراب الضوء على الجوانب التالية على وجه التحديد:
- تطبيع الإبادة الجماعية: يشير هذا إلى العملية التي تصبح من خلالها الإبادة الجماعية مقبولة أو أقل إثارة للصدمة مع مرور الوقت. هذه الظاهرة جزء من سياق أوسع: العرب وعقد من التطبيع مع العنف الذي يشير إلى تعرض مجتمعي مطول للعنف يمكن أن يؤدي إلى التطبيع معه.
- التباعد الاجتماعي: تساهم هذه الآلية في التطبيع من خلال خلق مسافة نفسية بين الأفراد أو الجماعات والفظائع، مما يسهل قبولها أو تجاهلها.
- دور الاستقطابات حيث تلعب دورًا مهمًا في تشكيل التصور العام تجاه المقاومة، ويمكن أن تسهل القبول الضمني بالإبادة من خلال التأثير على كيفية فهم الناس للأحداث والتفاعل معها.
- التكيف المعرفي مع الإبادة: تصف هذه العملية النفسية التي يضبط فيها الأفراد أطرهم ومعتقداتهم المعرفية للتعامل مع الإبادة الجماعية المستمرة أو تبريرها. فهو يتطلب تحولًا في الفهم يسمح بقبوله.
- كتم أنفاس التعاطف بالعقلانية: عنصر نفسي حاسم، يتضمن تجاوز مشاعر التعاطف والشفقة الطبيعية بتبريرات أو حجج “عقلانية”. يُعدّ قمع التعاطف عاملًا قويًا في تمكين الأفراد والمجتمعات من التكيف مع الإبادة الجماعية وتطبيعها.
- المواطن العربي المنهك وتنافس الأولويات: من وجهة نظر نفسية اجتماعية، يُقدَّم “المواطن العربي المنهك” على أنه شخص قد يشعر بالمأساة ولكنه في الوقت نفسه مثقل بـ “أولويات وضغوط أخرى”. يشير هذا إلى أن القدرة الفردية والجماعية على مقاومة الإبادة الجماعية أو معارضتها بنشاط يمكن أن تتضاءل عندما يغمر الناس المصاعب الشخصية والضغوط المجتمعية الأوسع، مما يساهم بشكل غير مباشر في التكيف والتطبيع.
توضح هذه العناصر مجتمعة كيف يمكن للمجتمعات أن تتصالح تدريجيًا مع أهوال الإبادة الجماعية، أو حتى تقبلها، من خلال مزيج من آليات التكيف النفسية، والمؤثرات الاجتماعية، والعوامل السياسية/الاقتصادية.
رابعًا: تحليل الخطاب والسرد والأيديولوجيا
يركز هذا النهج على كيفية نزع الصفة الإنسانية، والسيطرة على السرد وصناعة التوحش. ويتم التدقيق في “حروب الكلمات والسرديات”، بما في ذلك كيفية “تأطير الصراع”.
ويتم تطبيق عدسة أيديولوجية لفهم “الذنب التاريخي والتسامح الأخلاقي”، في إشارة إلى الهولوكوست، وكذلك دور “كراهية الإسلام والعنصرية ضد العرب”، و”أيديولوجية القتل الجماعي” التي ينتجها اليمين المحافظ، في إشارة إلى تفوق العرق الأبيض المحافظ – كما تظهر في الجماعات المؤيدة لترامب.
ويتم التعامل مع تحليل الخطاب والتحكم في السرد باعتبارهما عنصرين أساسيين في فهم قبول الإبادة الجماعية، وخاصة في سياق الأحداث في غزة.
أحد الجوانب الرئيسة التي تم تسليط الضوء عليها هو “نزع الصفة الإنسانية والسيطرة على السرد”، ويشير هذا إلى أن التحكم في السرد ينطوي على تجريد الأفراد أو المجموعات من إنسانيتهم، وهو عامل مهم في تسهيل اقتراف الإبادة الجماعية.
علاوة على ذلك، يمكن أن نشير إلى “حروب الكلمات والسرديات” كوسيلة لتصنيف الصراعات اللفظية المختلفة المحيطة بهذه الأحداث، كما أشار الصديق بسام بو نيني في كتابه. يشير هذا إلى أن اللغة والقصص المستخدمة (“الخطاب” و”السرديات”) موضع خلاف نشط، وتلعب دورًا في تشكيل التصورات، وربما تمكين العنف أو تطبيعه.
كما يظهر مفهوم “نزع الإنسانية وصناعة التوحش” في هذا النهج، مما يزيد من الربط بين كيفية مساهمة بعض الخطابات في تهيئة بيئة يصبح فيها العنف المتطرف، كالإبادة الجماعية، أمرًا ممكنًا أو مقبولًا.
خامسًا: التحليل الجيوسياسي وتجديد الإمبريالية
ويمكن فهم الإبادة الجماعية في غزة في ضوء تاريخ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي وتجديد الإمبريالية من خلال دراسة كيفية تأطير الأحداث الجارية ضمن هذه السياقات الأوسع.
وعلى وجه التحديد، فإن “الحرب على غزة” مرتبطة بشكل مباشر بتجديد الإمبريالية وصعود الدولة الحضارية. ويشير هذا إلى أن الصراع الحالي ليس حدثًا معزولًا، بل هو جزء من نمط أكبر لعودة للممارسات الإمبريالية التقليدية المرتبطة باحتلال الأرض والقضاء على السكان الأصليين والسيطرة عليها ولو من مدخل الاستثمار العقاري.
علاوة على ذلك، يتم تقديم الوضع في غزة باعتباره تطورًا من “اقتصاد الاحتلال” إلى “اقتصاد الإبادة الجماعية”. وقد تم استكشاف هذا المفهوم في تقرير أعده المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م.
يسلط هذا الارتباط الضوء على كيفية تطور الاحتلال طويل الأمد والهياكل الاقتصادية المرتبطة به، والتي ترتبط ارتباطًا جوهريًا بمشروع الاستيطان الإسرائيلي، إلى سياق يمكن أن تحدث فيه الإبادة الجماعية.
إن التحول من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية يعني تحويل النظام القائم للسيطرة والاستغلال إلى نظام يسهل القتل الجماعي.
ومن التطورات الجيوسياسية التي يجب الاعتناء بها؛ تصاعد دور بعض دول الجنوب في مناهضة الإبادة، وهو ما يجب أن يفهم في سياق العملية الجارية لإعادة صياغة علاقة دول الجنوب بالدول الاستعمارية السابقة.
سادسًا: دور التكنولوجيا والأنظمة الآلية في ارتكاب الإبادة أو تسهيلها
تلعب التكنولوجيا دورًا في تسهيل الإبادة الجماعية، كما يشير إلى ذلك مفهوم “الإبادة الجماعية الخوارزمية”.
يصف مفهوم “الإبادة الجماعية الخوارزمية” (Algocide) مرحلة جديدة حيث يتم تفويض الحق في الحياة والموت إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يتيح إبادة منهجية ودقيقة للغاية. ويشمل ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد المزيد من الأهداف وتخفيف القيود المفروضة على الخسائر المدنية.
يسلط هذا الاقتراب الضوء على العلاقة المباشرة بين الأنظمة التكنولوجية، وخاصة الخوارزميات، وتنفيذ أو تسهيل أعمال الإبادة.
أخيرًا: موضوعات مقترحة
أ- محددات عامة:
هناك عدد من المحددات التي يمكن أن تحكم هذه الموضوعات أهمها:
١- إثراء الإطار التفسيري بما أنتجته دراسات المحرقة (الهولوكوست)، مع ضرورة تقديم محرقة غزة باعتبارها استكمالًا لهذا الجهد وامتدادًا له.
٢- وضع هذه الدراسات في سياق إنساني أوسع يتحقق من خلال مفهومين بالغا الأهمية وهما: التقاطعية بين المعضلات التي تواجهها البشرية وكيف تبرز محرقة غزة هذا التقاطع استنادًا إلى مفاهيم العدالة في جميع المجالات: البيئية، والعرقية، والاقتصادية، والجندرية، وغيرها.
أما المفهوم الثاني فهو ما أطلقت عليه “سياسة غزة”، وهي السياسة التي تظهر في مساحات التقاطع بين تأييد ودعم الفلسطينيين وبين القضايا الخاصة التي تهم قطاعات محددة مثل اليسار أو السكان الأصليين أو النسويات أو حتى مجتمع الميم.
٣- القدرة على الاستفادة من الدراسات لتأسيس مبادرات متعددة، مثل بناء شبكات من مؤسسات وشخصيات مناهضة للإبادة، أو استكمال بعض الأدوار التي أظهرها التحرك ضد الإبادة مثل دور بعض دول الجنوب، أو رصد مبادرات التوثيق.
٤- وضع مثل هذه الموضوعات على الأجندة البحثية العربية، وتكوين مختصين بها.
٥- الانتقال بدراسات الإبادة إلى دراسات الاستبداد؛ فهناك دروس كثيرة يمكن الاستفادة منها في التعامل مع القمع الذي تنتجه هذه النظم تجاه مواطنيها أو مجموعات سكانية محددة.
٦- نحن ندرك أن المحرقة الدائرة في غزة تدور في سياقات أوسع تتعلق بتغيرات كبرى في العالم، لكننا في هذه المجموعة من البحوث لن نتطرق بشكل أساسي إلى تداعيات المحرقة على عدد من القضايا الهامة مثل: نهاية الحداثة، تقويض الديموقراطية، نهاية التاريخ، النظام الدولي المبني على القواعد، تغير هيكل القوي في النظام الدولي …إلخ. هي موضوعات مهمة ولا شك لكنها تحتاج إلى جهد وموارد لعلها تتوفر لجولة أخري من البحث.
ب- أما الدراسات المقترحة، فقد آثرت أن أجعلها قليلة العدد؛ إدراكًا لحدود الموارد والطاقات، ولكنها قد تكون فتحًا لما بعدها:
١- من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة: تُظهر الوقائع في محرقة غزة كيف أن الأنظمة الاقتصادية العالمية، مدفوعةً بمنطق رأسمالي مُتوحش، ومدعومة بقوى سياسية مُتورطة في التعتيم والتواطؤ، تختزل البشر بشكلٍ مُمنهج إلى مجرد سلعٍ قابلة للاستهلاك، أو مُدخلات اقتصادية، أو مجرد مُشاهدين.
وفق هذا المنطق، تدعم الشركات زيادة الحروب من خلال عدة آليات، مدفوعة في المقام الأول بالمصالح المالية، والتأثير السياسي، والترويج للتقنيات العسكرية الجديدة. ويصبح السؤال كيف تدعم هذه الشركات الحروب الجديدة؟، وكيف تديمها لأطول فترة ممكنة؟
٢-الإبادة الخوارزمية؛ هكذا تقتلنا شركات التكنولوجيا؟
وفيها ندرس كيف تتم محرقة غزة بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة للغاية لتسهيل عملية التدمير، وكيف ننتقل من من “حق القتل” للجندي أو السياسي إلى “حق الخوارزمية في القتل”.
يبرز مع هذا النوع دور التكنولوجيا وخاصة المعلومات، وتطور طبيعة الأسلحة في القرن الحالي وتأثيرها في الإبادة.
والأمر الحاسم هو أن هذه القدرات الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي قد تجعل الحرب “أكثر احتمالية وأكثر فتكًا”. الخطر أن تتمكن الأسلحة المستقبلية من اختيار أهدافها دون تدخل بشري، خاصة أن سياسة الجيوش الحالية يحركها المنطق العسكري القائل بأن السرعة في تدمير الأهداف ستكون ذات أهمية قصوى في الحروب عالية التقنية.
٣- أبرز وأهم سمات وملامح محرقة غزة من خلال قراءة في التقارير الحقوقية التي صدرت من منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات الدولية، بالإضافة إلى التحقيقات الاستقصائية لوسائل الإعلام المتنوعة.
٤- خريطة المجموعات الفاعلة في مناهضة المحرقة، مع رصد لمساحات سياسة غزة والتقاطعية بين تطلعاتهم وبين تأييد الفلسطينيين.
بالطبع يمكن تخصيص دراسة مستقلة لموقف المجموعات اليهودية التي تساند الفلسطينيين: موقف اليهود المناهضين للإبادة، تحليل ورسم خرائط.
٥- دراسة لأبرز الشخصيات الفكرية أو الباحثين الغربيين والإسرائيليين المناهضين للمحرقة، مع تتبع تطور مواقفهم، والحجج التي استندوا إليها في بناء هذا الموقف.
٦- وهناك موضوع حساس، لكن لا يمكن إغفاله، وهو الممارسات الإبادية لحماس في يوم ٧ أكتوبر.
اعترفت حماس بهذا ضمنيًّا في الوثيقة التي أصدرتها شرحًا لعمل الطوفان، كما أن هذا الجهد مفيد للمقاومة المسلحة على المدى القريب والبعيد، فقد تعلمنا في دراسات تحويل النزاعات ضرورة تدريب المقاتلين في الصراعات على القانون الدولي الإنساني بقصد احترامه، لأن هذا يكسبهم مزيدًا من الشرعية الدولية والإقليمية، ناهيك عن ارتباطه الأساسي بمرجعية حماس الإسلامية.
٧- الجنوب والتحول من عدالة المنتصر إلى عدالة الضحية: وفيه نتخيل دورًا مهمًا ومتطورًا لدول الجنوب في منع الإبادة الجماعية، مسلطًا الضوء على مساهماتها التاريخية ونشاطها المعاصر المتزايد.
السؤال: هل يمكن لدول الجنوب العالمي أن تكون قوة حاسمة ومؤثرة بشكل متزايد في إعادة تشكيل القانون الدولي والحوكمة العالمية لضمان التنفيذ الكامل وغير التمييزي لاتفاقية الإبادة الجماعية، والتحرك نحو نظام يعطي الأولوية للوقاية والعدالة لجميع الضحايا، بدلًا من التأثر بالمصالح الجيوسياسية أو التحيزات التاريخية؟
٨- لماذا العمى الأخلاقي في إسرائيل؟: في تفسير موقف الجمهور الإسرائيلي من محرقة غزة، وطبيعة المشروع الصهيوني قي طبعته الحالية.
٩- كيف تتورط في إبادة جماعية؟
تسويغ الإبادة: دراسة في الخطابات العربية الرسمية وغير الرسمية التي أدت إلى القبول الضمني بالإبادة.
يرتبط بهذا ظاهرة أخرى وهي كيف يتم “تسليع الإبادة” من خلال دراسة حالة غزة -كما ظهرت في السوشيال ميديا وتغطية بعض محطات الأخبار.
١٠- الاعتبار والاستبصار: أبرز الدروس التي يمكن استخلاصها من محرقة غزة.
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر
١٩ سبتمبر/ أيلول ٢٠٢٥م