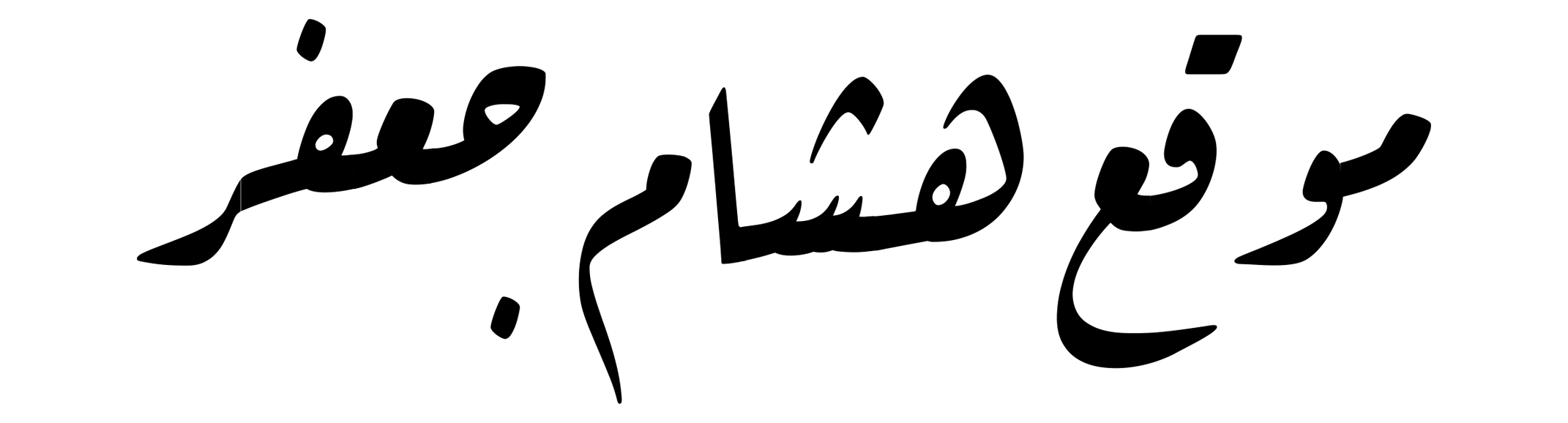هذا المقال قراءة في الكتاب الهام الذي صدر الأيام القليلة الماضية باللغة الانجليزية وحمل عنوان: The Political Economy of Education in the Arab World
الذي حرره هشام علاوي، وروبرت سبرنجبورج
منذ تشكل وعينا بالهم العام -أوائل الثمانينات من القرن الماضي- ولفظة «الإصلاح التعليمي» يتم تداولها بدأب شديد من قِبل الحكومات المتعاقبة وأنظمة الحكم المتعددة ما جعلها لفظة سيئة السمعة في الإدراك العام عند قطاعات مُتسعة من المواطنين الذين باتوا يتساءلون هل «الإصلاح التعليمي» في مصر بات تسمية خاطئة؟
وللمفارقة فمؤشرات التعليم العام في مصر تدل على أنه مكلف للأسر المصرية خاصة الفقراء، كما أنه سيئ في العموم (تم تصنيف النظام من قِبل المنتدى الاقتصادي العالمي على أنه في المرتبة 130 من أصل 137 في العالم، حيث احتل التعليم الابتدائي المرتبة 133، وهو أدنى ترتيب لمصر في ما يقرب من 100 مؤشر تم بناء مؤشر التنافسية العالمية منها). وبرغم زيادة الطلب عليه فلم يعد سبيلًا للحراك الاجتماعي، وبات سببًا مهمًا للاستياء السياسي، فإن أكثر من ثلث العاطلين عن العمل في مصر حاصلون على درجات جامعية أو دراسات عليا. والنتيجة كما لاحظ البنك الدولي هي أن «الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها مصر حققوا مستويات تعليم أعلى بكثير من آبائهم، وأكثر من أي منطقة في العالم. فقد أنتجت إجراءات الوصول والإتاحة المُتسعة أعلى تنقل بين الأجيال في مجال التعليم في العالم» ومع ذلك، لسوء الحظ، فإن «التنقل في الدخل منخفض» و«عوائد التعليم في سوق العمل هي من بين أدنى المعدلات في العالم»
يجادل كاتب هذه السطور أنه إذا كان هناك حل لضعف الأداء المزمن لأنظمة التعليم المصرية، فإنه يجب أن يشمل هذا الحل المشكلات السياسية والاقتصادية الكامنة أولًا، وليس فقط القضايا التقنية أو التربوية المتعلقة بممارسة التعليم. فالجودة الوطنية تظل منخفضة برغم الجهود القوية التي يبذلها المحللون والممارسون والمنظمات الدولية لفهم الأسباب ومعالجتها، ويلاحظ في هذا الصدد أن الإصلاحات المقترحة ركزت بشكل أساسي على التغلب على مشكلات التمويل، والقيود التقنية، وتحسين الوصول والبنية التحتية، بدلًا من الاهتمام بالمشكلات النظامية المتجذرة في الاقتصادات السياسية في المنطقة ومنها مصر والتي تعتمد في المقام الأول على صادرات المواد الخام وفي مقدمتها المحروقات، وبدرجة أقل، المساعدات الخارجية ورؤوس الأموال الخارجية الأخرى. مما أدى إلى ما يسميه الاقتصاديون الجدد نظم الوصول المحدودة.
بعبارة أخرى، فإن أجندة الجدل العام حول «إصلاح التعليم» في مصر يجب أن تتغير لتتركز أكثر حول السياقات السياسية والاقتصادية التي يتحرك فيها هذا الإصلاح، بالإضافة إلي ضرورة إدماج أصحاب المصلحة -من طلاب وأسر ومعلمين وإداريين ومنظمات أعمال- في أي عملية اصلاح.
نظم الوصول المحدودة
تقدم لنا دراسات التنمية هذا المفهوم لفهم النظم التعليمية المختلفة، في هذه النظم نحن بإزاء اقتصادات سياسية منظمة لتضخيم القوة السياسية والمكافآت الاقتصادية لصالح تحالف نخب الحكم، مع حرمان أي شخص آخر منها لأنهم مجمعون على أنهم «غرباء»
نظم الوصول المحدودة تضع قيودًا على الوصول إلى الوظائف السياسية والاقتصادية القيمة (تأمل معي كيف سيّطرت المحسوبية على التعيين في الوظائف الهامة في مصر) كوسيلة لتوليد العوائد التي يتم إنشاؤها من خلال القيود المفروضة على الوصول إلى الموارد والوظائف، وعن طريق الحد من أشكال التنظيم التي تعبّر عن مصالح فئات المجتمع الأكبر.
تستخدم النخب في نظم الوصول محدودة العوائد للحفاظ على النظام الاجتماعي القائم، والنظام السائد بما يتضمنه من توزيع للسلطة والثروة، وفيه يتلاعب النظام السياسي بالاقتصاد لتوليد ريع يربط مصالح الفاعلين الاقتصاديين لدعمه وضمان استمراره. ويعد تقييد الوصول إلى الأشكال التنظيمية وإسناد العقود هو مفتاح فهم هذه النظم: فهو يخلق عوائد من خلال الامتيازات الحصرية ويعزز بشكل مباشر قيمة الامتيازات من خلال جعل النخب أكثر إنتاجية من خلال مؤسساتها. إن إنشاء الريع من خلال التنازل عن الحقوق والامتيازات الحصرية، والقمع الانتقائي للمنافسين هو في قلب هذا النظام، فخلق الريع يوفر الصمغ الذي يربط التحالف معًا، ويمكّن مجموعات النخبة من تقديم التزامات ذات مصداقية لبعضها لدعم النظام وأداء وظائفها. ويشترك الجميع في المبدأ الأساسي المتمثل في التلاعب بالاقتصاد لإنتاج العوائد وتحقيق الاستقرار، ومنع التنافس المحتمل من الجماعات الأخرى الراغبة في تغيير النظام أو المنافسة لتحالف الحكم فيه.
وفق هذا المنظور تصبح الإصلاحات التعليمية دائمًا في مصر مدفوعة جزئيًا بالاستياء الشعبي من نظام التعليم في البلاد، لكن النظام يختار الرد على هذا الضغط بطرق تناسب مصالحه ومصالح نخبته أكثر بكثير من مصالح معظم أفراد الجمهور، لا سيما أولئك المنتمين إلى الطبقات المتوسطة والدنيا. ويتحول المقصد من السياسات التعليمية إلى خفض الإنفاق الحكومي عليه (من المفارقات أن وزير التعليم الحالي يطالب فقط بمليار ونصف دولار لا يتم الموافقة على تخصيصها له في حين أُنفق تريليون جنيه على قطاع النقل)، وتدريب المنفذين المطيعين لسياسات النظام، وتعزيز ولاء الشباب للأمة المصرية ومَن يتحكم فيها.
ولكن كيف يتم الوصول إلى ذلك؟
عقود اجتماعية لمراحل ثلاث
العقد الاجتماعي هو إطار العلاقات بين الدولة والمجتمع حيث يعترف المواطنون بحق الدولة في الحكم مع التزامات معينة تقع على عاتقها في المقابل.
يبيّن العقد الاجتماعي الجزء الغاطس من أي نظام سياسي من جهة الفئات الاجتماعية التي تسانده نتيجة إعادة تخصيص الموارد لصالحها وبما يخلق الشرعية التي تحتاج إلى قاعدة اجتماعية واسعة بما يكفي لتكون مستدامة. ولتحقيق الشرعية يحتاج الحكام إلى التحالف مع طبقات وفئات اجتماعية مختلفة، فالدولة متأصلة في مجموعة ملموسة من الروابط الاجتماعية التي تربطها بالمجتمع وتوفر قنوات مؤسسية للتفاوض على الأهداف والسياسات.
وفق هذا المنظور، فقد مر النظام التعليمي المصري بمراحل ثلاث. الأولى: مرحلة ما بعد 1952 مباشرة وفيها تم إصلاح «الوصول» الذي اتخذ شكل التوسع في النظم التعليمية على جميع المستويات. وكان العامل الدافع هو خلق موارد تعليمية جديدة بما في ذلك المباني والمدرسين والمواد التعليمية، وكان عامل الجذب هو التوظيف العام للخريجين حتى من المدارس الثانوية. كانت هذه الموجة مدفوعة بكل من الوفرة السياسية المرتبطة بالاستقلال والوفرة النسبية للموارد. ولم يُنظر إلى الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي في المقام الأول على أنه وسيلة لبناء رأس المال البشري والمجتمع المدني القوي في مواجهة سلطة الحكم، بل كان يُنظر إليه على أنه وسيلة لضمان الإذعان أو سبيل للمقايضة السياسية بتوفير الفرص الاقتصادية والمزايا الاجتماعية (الحراك الاجتماعي) مقابل التنازل عن الحرية السياسية.
بات التحول المقيد بعد هزيمة 67 عن هذه الصيغة محتمًا لنقص الموارد التي يمكن تخصيصها للخدمات العامة وفي مقدمتها التعليم، مع حدوث تحول في الاقتصاد في الثمانينيات من القطاع العام للخاص الذي يجب أن يستوعب العمالة، إلا أن هذه التحولات لم تأخذ مداها نتيجة وجود عدد من الكوابح الاجتماعية التي منعت النظام من التمادي أو الوصول إلي آخر هذه الصيغة. وفي هذا الإطار يمكن فهم التحدي الذي مثلته ثورة يناير 2011 لهذه الصيغة والتي كان من أسبابها الاحتجاج على تدهور الخدمات العامة وفي مقدمتها التعليم.
في هذه المرحلة الثانية حدث تحول -وإن كان على استحياء- في مقصد التعليم من خلق بيروقراطية وطبقة وسطى تدعم النظام إلي عمالة يتم توظيفها في القطاع الخاص الذي اتسع بالتدريج منذ تسعينيات القرن الماضي.
تجتاح المنطقة الآن- ومنها مصر- موجة ثالثة من التغيير التعليمي، مدفوعة في المقام الأول باليأس المتزايد، أو ما يُمكن وصفه أيضًا بالواقعية الأكبر للأنظمة القائمة في ظل ضغوط الميزانية المتزايدة الناتجة عن تراجع أسعار المحروقات منذ عام 2014، والضغوط الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي فرضها ذلك على جميع البلدان العربية، والتي تفاقمت أوضاعها الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، فتسعى معظم الأنظمة إلى الحد من الإنفاق على التعليم، وتوجيهه نحو تسريع التحول في تركيزه بعيدًا عن تدريب موظفي الخدمة المدنية المحتملين.
وفق هذا التحول، فإن السلطات المصرية اليوم تسعى لإصابة ثلاثة طيور بحجر واحد: إداري وآخر سياسي وثالث تنموي. إنها تريد إنتاج كوادر إدارية تكنوقراطية تابعة ومخلصة لمؤسسات الدولة لتولي الوظائف الإدارية التي تؤديها تقليديًا البيروقراطية الأكثر استقلالية، كما أنها تريد من تلك الكوادر أن تتولى وظائف الوسيط السياسي بين المواطنين وأجهزة الدولة لفرض حكمها وإضفاء الشرعية عليها (مؤتمرات الشباب وتنسيقيتهم الحزبية)، وثالثًا تأمل أن تساهم هذه الكوادر المتخرجة حديثًا في الظهور الموعود لاقتصاد المعرفة الذي هو رطانة أكثر منه حقيقة (التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة).
خصخصة التعليم والطبقية الجديدة
بدافع من الضرورات المالية -كما قدمت- وكذلك الرغبة في تحسين الجودة التعليمية، والرغبة الأقوى في تدريب نخبة إدارية تكنوقراطية جديدة، تسعى الحكومة إلى خصخصة التعليم على جميع المستويات. فحوالي 10% من الطلاب في المراحل التعليمية من الابتدائية حتى الثانوية، أي حوالي 2 مليون من أصل 18-20 مليونًا، موجودون حاليًا في المدارس الخاصة، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط العالمي وحتى أقل من ذلك بالنسبة للبلدان المتوسطة الدخل. ورغم ذلك فإن هناك ملاحظة جديرة بالاعتبار وهي، أنه مثلما تم تخريب الأغراض الإصلاحية للخصخصة الاقتصادية من قِبل المقربين ورعاتهم السياسيين الذين تعاونوا للاستيلاء على موارد الدولة والسيطرة على الأسواق، كذلك من غير المحتمل أن تكون خصخصة التعليم مثالًا نموذجيًا للنجاح (تأمل شكاوي المصريين المتصاعدة من التعليم الخاص برغم ما يُدفع فيه من أموال)
في البلدان الأفقر، مثل مصر، تهدف الخصخصة في المقام الأول إلى تخفيف أعباء الميزانية، وتسهيل توظيف النخبة بدلًا من أن تصبح دافعة للإصلاح بالمعنى الواسع له، ومن المرجح أن تؤدي إلى تفاقم أوجه القصور التعليمية الناتجة عن عدم المساواة بدلًا من حلها، وستكون النتيجة تأسيس نظام ثلاثي على جميع المستويات: مؤسسات عامة مجانية في القاع تلبي احتياجات الأكثر فقرًا، والمؤسسات متوسطة المستوى التي تشترك في نوع من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتجذب أفراد الطبقة الوسطى الذين يمكنهم دفع رسوم تناسب دخولهم، والمدارس والجامعات الخاصة الدولية الراقية التي تلبي بشكل كبير احتياجات أثرياء مصر.
وبالتالي، تعمل الحكومات على تقسيم النظم التعليمية إلى مزيد من الطبقية، وتتخلى ضمنيًا عن التطلع إلى تحقيق تعليم شامل بجودة معقولة، وهم يسعون إلى تعزيز نظم الوصول المحدودة الخاصة بهم بإنتاج فئات مؤهلة تقنيًا ومخلصة سياسيًا عبر أنظمة تعليمية متنوعة بشكل متزايد. ويتحول الوعد بإنشاء «اقتصاديات المعرفة» على أساس الموارد البشرية المحسنة إلى شعار سياسي أكثر من كونه استراتيجية مدروسة بعناية للنمو الاقتصادي، وتصبح البطالة أو العمل الهامشي (بدوام جزئي أو غير رسمي) هي المصير الذي ينتظر نسبًا كبيرة من خريجي المدارس الثانوية والجامعات.
تشير الدراسات الميدانية حول تأثيرات عدم المساواة على التعليم الابتدائي في مصر إلى أن «التعليم الأساسي المجاني يخذل الأطفال المصريين» الذين يتعين عليهم التعامل مع نظام مشوه حيث يوجد تفاوت كبير في التعليم الأساسي اعتمادًا على ظروف كل أسرة ومستوى دخلها. ومما يزيد من تفاقم المشكلات، تناقص الموارد للفرد وسوء تخصيصها نتيجة التوزيع غير العادل لها. فمعامل جيني -الذي يقيس المساواة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- أعلى بكثير من تلك الخاصة بمناطق العالم المختلفة (يستحوذ العُشر الأعلى دخلًا على أقل بقليل من ثلثي الدخل القومي الإجمالي، مقارنة بـ37% لأوروبا الغربية و47% للولايات المتحدة، و55% للبرازيل) وبالتالي فإن السياق العام الذي يتم فيه تقديم الخدمات التعليمية لا يفضي إلى إنجازات تعليمية متوازنة كما يتم إنتاجها عادةً في الاقتصادات السياسية الأكثر إنصافًا، ففي قطاع التعليم، يميز عدم المساواة تخصيص الموارد الحكومية والوصول إليها، وبالتالي يلعب دورًا حاسمًا في تحديد النتائج التعليمية.
إدماج أصحاب المصلحة
تُظهر مقارنة إصلاح التعليم العالي في مصر والمغرب أن كلا البلدين قد اتخذ عدة خطوات لتكييف الجامعات مع سوق التعليم العالمي. لكن المقارنة تكشف أيضًا عن تباينات مهمة في كيفية إعداد النظامين للإصلاحات وتنفيذها، فبينما اختار المغرب عملية صنع قرار أكثر شمولًا، تتميز عملية الإصلاح في مصر بقدرة النظام المحدودة على دمج مختلف أصحاب المصلحة، من خلال المحسوبية، وعدم معالجة قضايا الإصلاح المثيرة للجدل.
تعتمد الملكية المغربية على قدرة غير عادية على بناء تحالفات جديدة ودمج فاعلين جدد، وتوسيع نطاق التعددية عند الضرورة، وهذا يزيد من تآكل المعارضة. وفي هذه الحالة فإن النظام الملكي المغربي، هو أكثر نجاحًا في بناء حاجز ضد الاحتجاج حيث كانت المشاركة الواسعة لأصحاب المصلحة في عملية الإصلاح مهمة لنشر المسؤولية عنه على أكتاف متعددة، لذا أبقى الإصلاح قادة الجامعات والأساتذة والطلاب مشغولين، بينما في مصر فإن الإصلاحات عادة ما تتم من أعلى إلى أسفل وتصدر في غياب مشاركة ذات مغزى لأصحاب المصلحة، ويجري تبريرها كاستجابة للضغوط من القاعدة الشعبية إلى القمة وباعتبار الحكومة تقف في وجه المصالح الأنانية الراسخة لبعض الفئات التي تملك تأثيرًا على العملية التعليمية، وخاصة المعلمين.
ومع ذلك، فإن هذه السياسات تحيد بعمق عن أفضل الممارسات في الإصلاح التعليمي والتي تؤكد على الحاجة إلى مشاركة أصحاب المصلحة من قِبل الآباء والمعلمين والطلاب والإداريين وأرباب العمل، إلى جانب استقلالية الجامعات المعززة ضمن إطار لا مركزي.
بعبارة أخرى، فإن إصلاح التعليم في مصر -في جزء كبير منه- يرتبط بمدى قوة واستقلالية منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها النقابات المهنية ونوادي أعضاء التدريس، ومدى دمجها في في صنع السياسات. كما يتأثر بطبيعة السلطة السياسية ومدى انشغالها بالسيطرة السياسية في كل مكان. كما أن هذه الممارسة تعمق نظم الوصول المحدودة التي لن تمكن «الغرباء» عن تحالف الحكم من المشاركة في عمليات صنع القرار حتى لو كانت مشاركتهم من شأنها تحسين نواتج السياسة. وأخيرًا، فلقد أدت رأسمالية المحاسيب التي اتسم بها النظام الاقتصادي المصري إلى إضعاف برجوازية القطاع الخاص المدافعين التقليديين عن جودة التعليم، وأضعفت الوظيفة العامة أيضًا.
قد يكون الإصلاح التعليمي في البلدان العربية الأخرى أكثر انفتاحًا على مشاركة أصحاب المصلحة، وأقل تقيدًا من الناحية المالية، وغير مدفوع تمامًا بانشغال النظام بغرس الولاء، وخلق كوادر إدارية مطيعة، وردع المعارضة أو حتى التعبير عن عدم الرضا عن الخدمات الحكومية. فإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا الإصلاح سوف يلتزم بشكل أوثق بأفضل الممارسات الدولية، ومن المحتمل -بالتالي- أن يكون لديه إمكانيات أفضل للنجاح. لكن في حالة مصر، فإنه يتم العمل على الدوافع العالمية المشتركة للإصلاح التعليمي سعيًا وراء مصالح النظام مع القليل من الاهتمام بمعايير أفضل الممارسات المجردة أو تفضيلات أكثر واقعية لأصحاب المصلحة.
تطول أجندة الجدل العام حول «إصلاح التعليم» في مصر وتتعدد، ولكن في جلها تخرج عن القضايا الحقيقية التي يجب مناقشتها، والتي تم اختزالها هذه الأيام في استخدام التابلت من عدمه، أو نظم الامتحانات بما جعلني أسمع عن الإصلاح من خمسة عقود ولا أرى منه إلا القليل.